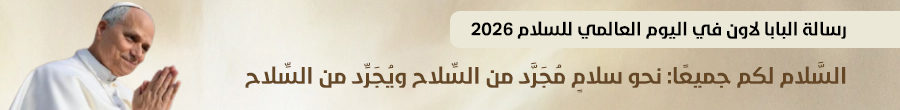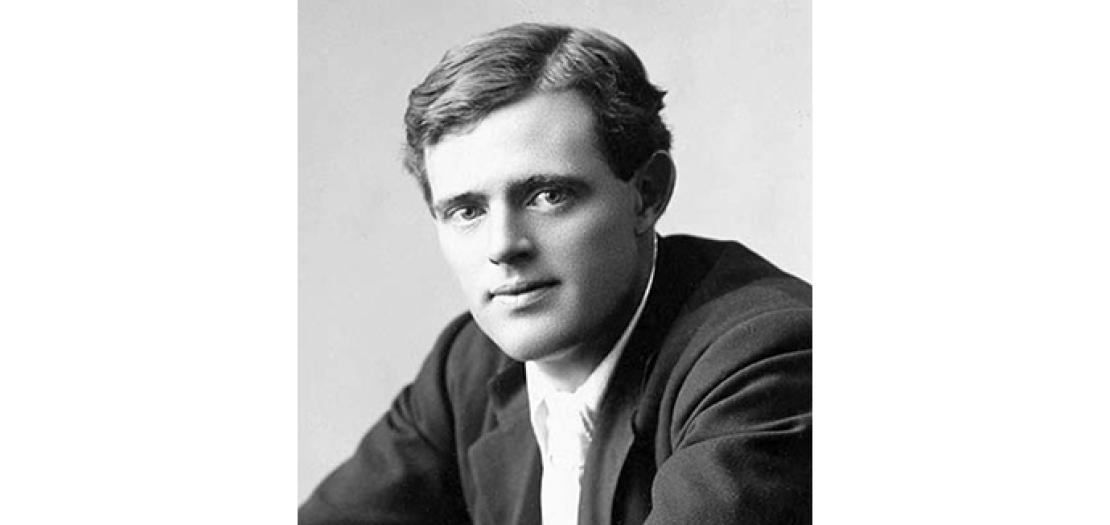موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
قراءة لاهوتيّة وصوفيّة وإشراقيّة في مقولة جاك لندن

رمزي ناري - الأردن
«أُفَضِّلُ أن أكونَ رَمادًا على أن أكونَ غُبارًا.
أُفَضِّلُ أن تتوهَّجَ شَرارتي في لَهيبٍ ساطعٍ،
على أن يَخمُدَ أوارُها في عَفَنِ الخُمول.
أُفَضِّلُ أن أكونَ نيزكًا مُتألِّقًا،
وكلُّ ذرَّةٍ مِنِّي تتوهَّجُ ببريقٍ أخّاذ،
على أن أكونَ كوكبًا أبديًّا خامدًا.
وظيفةُ الإنسانِ أن يَحيا،
لا أن يَبقى موجودًا فحسب.
لن أُضيِّعَ أيّامي في إطالتِها عبثًا،
بل أَنتفِعُ منها أبدًا».
يُقَدِّمُ النصُّ المنسوبُ إلى جاك لندن نموذجًا مُكثَّفًا لفلسفةِ الحياة في صورتها الأكثر توتُّرًا، إذ يُعلِنُ صاحبُه أنّه يُفَضِّلُ أن يكونَ رمادًا على أن يكونَ غُبارًا، وأن تتوهَّجَ شرارتُه في لحظةٍ مُضيئةٍ على أن تذوي في عَفَنِ الخُمول، وأن يتحوَّلَ إلى شِهابٍ يتألَّقُ بكلِّ ذرّاتِه بدلًا من أن يكونَ كوكبًا ساكنًا يَخمُدُ طويلًا بلا أثر. هذه الاستعاراتُ ليست مجرَّدَ زخارفَ لغويّة؛ إنّها بناءٌ فلسفيٌّ متكامل يُقَدِّمُ رؤيةً محدَّدة لمعنى الحياة، وطريقةِ وجود الإنسان في العالم، وثنائيّةِ الفعلِ والرُّكود، والزمنِ والغاية، والوجودِ والعيش.
يتحرَّكُ النصُّ من رمزيّةِ النار بوصفها صورةً للحياة، ومن رمزيّةِ الغُبار بوصفه علامةَ الجمود. فالرمادُ، في بنيتِه الرمزيّة، ليس نفايةَ الاحتراق، بل أثرَه، وشهادةً على أنّ نارًا عظيمةً مرَّت من هناك، وأنّ حرارةً ما أشعلت الوجود. أمّا الغُبارُ فهو بقايا الخُمول، ما يتكوَّنُ حين لا يحدثُ شيء، وحين تمرُّ الحياةُ بلا فعلٍ ولا أثر. وبين الرماد والغُبار تتحدَّدُ هويّةُ الإنسان: هل يُفَضِّلُ أن يكونَ أثرَ احتراقٍ حيٍّ، أم أثرَ سكونٍ طويل؟
وتقودُ هذه الثنائيّةُ إلى ثنائيّةٍ أُخرى مركزيّة: الشِّهابُ في مقابل الكوكب. فالشِّهابُ جِرمٌ يعبرُ السماء بوهجٍ خاطف، لكنَّه يتركُ أثرًا في العين والذاكرة، بينما الكوكبُ جِسمٌ ثابتٌ يدورُ في مسارِه الأبديّ من غير أن يُحدِثَ فرقًا أو يخلُقَ معنى. وهكذا يُعادُ تعريفُ الزمن: ليست قيمتُه في الامتداد، بل في الكثافة؛ وليست قيمتُه في عددِ السنوات، بل في مقدارِ ما يُنجِزُه من حضورٍ ومعنى.
هذا النمطُ من التفكير يجعلُ الإنسانَ مسؤولًا عن ملءِ اللحظة، لا عن إطالةِ الزمن. ولذلك يقولُ النصُّ: «وظيفةُ الإنسانِ أن يَحيا، لا أن يَبقى موجودًا فحسب»، وهي عبارةٌ تفتحُ البابَ على الأطروحةِ الوجوديّةِ الكبرى: التمييز بين الوجود بوصفه حالةً فيزيائيّةً خاملة، وبين العيش بوصفه فعلًا إراديًّا ممتلئًا بالقصد. هنا يتحوَّلُ الإنسانُ من عنصرٍ في الطبيعة إلى فاعلٍ في الوجود؛ من كائنٍ يستمرُّ إلى كائنٍ يصنعُ معنى. وهذا الفارقُ هو جوهرُ الفلسفةِ الوجوديّةِ الحديثة عند هايدغر وكامو وسارتر، غير أنّه يتقاطعُ – على نحوٍ لافت – مع رؤى روحيّةٍ أقدم، لاهوتيّةٍ وصوفيّةٍ وإشراقيّة، ترى أنّ النورَ الداخليَّ لا يُمنَحُ إلا لمن «يحترق» به وفيه.
الحياة بين الامتداد والامتلاء
يُميِّزُ النصُّ بين نمطين من الوجود:
الوجودُ المُمتدّ، الذي يقيسُ الحياةَ بالسنوات وتراكمِ الزمن.
الوجودُ المُكثَّف، الذي يقيسُ الحياةَ بدرجةِ ما تُحقِّقُه من معناها الخاص.
هذا التمييزُ ليس جديدًا في الفكرِ الدينيّ. ففي المسيحيّة، يُعَدُّ التفريقُ بين «الحياةِ الزمنيّة» و«الحياةِ الامتلائيّة» أساسيًّا. فقد أكَّد إيريناوس أسقفُ ليون (القرن الثاني الميلادي) أنّ «مجدَ الله هو الإنسانُ الحيّ، وحياةَ الإنسان هي معاينةُ الله»، حيث لا تُفهَمُ الحياةُ هنا بوصفها حياةً جسديّة، بل بوصفها انفتاحًا على مصدرِ المعنى.
وبالمثل، يرى مكسيموس المُعتَرِف (القرن السادس الميلادي) أنّ الزمنَ يصبحُ «مفردةً روحيّة» عندما يُعاشُ بوعي، وأنّ قيمةَ اللحظة تكمنُ في كثافتِها الأخلاقيّةِ والروحيّة، لا في طولِها.
وفي التصوّف الإسلاميّ، يُعادُ إنتاجُ المفهومِ ذاته من خلال التمييز بين «العُمر» و«الحياة»، إذ يُفهَمُ العُمرُ بوصفه امتدادًا، والحياةُ بوصفها حضورًا وتجلِّيًا. ويشيرُ أبو القاسم القُشيري إلى أنّ «اللحظةَ التي يَحضُرُ فيها القلبُ أرجى عند الله من عُمرٍ يُقضى في الغفلة»، وهو طرحٌ يُقارِبُ فكرةَ الامتلاء الوجوديّ.
أمّا الفلسفةُ الإشراقيّة فترى أنّ الجوهرَ هو «النور» لا «المدّة»، وأنّ المعرفةَ الحقيقيّة تتحقَّقُ بالكيفيّة لا بالكميّة. ويقولُ السُّهروردي إنّ «لحظةً من الشهود تُغني عن دهرٍ من الفكر، وصرخةً من المُحبّ تكفي عن ألفِ عامٍ من الذِّكر».
تتأسَّسُ الرؤيةُ محلُّ الدراسة على هذه الفكرةِ نفسها: الحياةُ الحقيقيّةُ تُقاسُ بدرجةِ حضورِ الإنسان فيها، لا بطولِها.
الاستعارةُ المركزيّة: الشِّهاب بوصفه نموذجًا للفاعليّة الإنسانيّة
يستخدمُ النصُّ صورةَ «الشِّهاب/النيزك» بوصفها مجازًا للحياةِ المتَّسِمةِ بالكثافة والفاعليّة. فالشِّهابُ، على قِصَرِ عمرِه، يتركُ أثرًا واضحًا في السماء، ويغدو نموذجًا لوجودٍ يتجاوزُ الزمنَ إلى الحضور.
ويرتبطُ هذا المجازُ بمفاهيمَ روحيّةٍ متعدّدة:
في المسيحيّةِ المُبكِّرة، تُفهَمُ الشهادةُ بوصفها فعلَ امتلاءٍ لا تمجيدًا للموت، بل تحقيقًا للمعنى في حياةٍ تُعاشُ بغاية. وفي التصوّف الإسلاميّ، يُستَخدَمُ «الاحتراق» رمزًا لتحوُّلٍ باطنيٍّ وانكشافٍ للحقيقة. أمّا في الإشراقيّات، فالنورُ هو جوهرُ المعرفة، والوميضُ – ولو كان لحظة – يحملُ من المعنى ما يفوقُ الامتدادَ الزمنيّ.
من خلال هذه الاستعارات، يكتسبُ الشِّهابُ قيمةً روحيّةً وفلسفيّة: إنّه رمزٌ لحياةٍ تتَّجهُ نحو غايةٍ سامية، وتتحقَّقُ بالفعل لا بالامتداد.
الزمن بوصفه مادّةً للمعنى
يرتبطُ مفهومُ الزمن في النصّ بفكرةِ الاستخدام؛ فالزمنُ ليس شيئًا يُحفَظ، بل موردٌ يُستثمَر. وهو تصوّرٌ حاضرٌ في تيّاراتٍ روحيّةٍ متعدّدة: ففي المسيحيّة، يُقالُ: «مُفتَدِينَ الوقتَ»؛ وفي الروحيّةِ السريانيّة، يُعَدُّ الزمنُ إمكانيّةَ الروح؛ وفي الفكرِ الإسلاميّ، يُوصَفُ الوقتُ بأنّه رأسُ مالِ الإنسان.
وبذلك ينفي النصُّ فكرةَ أنّ قيمةَ الزمن تكمنُ في امتدادِه، مؤكِّدًا أنّه لا يتحوَّلُ إلى معنى إلّا بالفعلِ الإنسانيّ الواعي.
الحياةُ بوصفها تحقيقًا للذّات الأخلاقيّة والروحيّة
لا تُقَدَّمُ الفاعليّةُ هنا بوصفها اندفاعًا فردانيًّا أو تمجيدًا للبطولة، بل بوصفها مسارَ تكاملٍ داخليّ. ففي المسيحيّة، يظهر ذلك في مفهوم «التألُّه»؛ وفي التصوّف، في ثنائيّة «الفناء والبقاء»؛ وفي الإشراقيّة، في ترقِّي النفس نحو مراتب أعلى من النور.
وعليه، فإنّ الحياةَ الفاعلة لا تعني المجازفة، بل تعني ممارسةَ الحرّيّة بوعيٍ ومسؤوليّة، واستثمارَ الإمكانات الإنسانيّة لتحقيقِ غايةٍ تتجاوزُ الذّات.
رؤيةٌ تجعلُ الحياةَ مشروعَ امتلاء
تكشفُ مقولةُ جاك لندن، في ضوء هذه القراءة، عن رؤيةٍ تجعلُ الحياةَ مشروعَ امتلاءٍ لا مجرَّد بقاء، وفعلًا مقصودًا لا استهلاكًا للزمن. إنّها دعوةٌ إلى أن يحيا الإنسانُ بكثافةٍ واعية، وأن يتركَ أثرًا يَشهدُ على احتراقِه بالنور والمعنى.
وبهذا المعنى، لا يعودُ الرمادُ علامةَ فناء، بل دليلَ حياةٍ اشتعلت، ولا يغدو الشِّهابُ رمزَ زوال، بل شاهدًا على وجودٍ اختار أن يكونَ حاضرًا، فاعلًا، ومُضيئًا في العالم.
جاك لندن (1876-1916) كان روائيًا وصحفيًا أمريكيًا شهيرًا، عُرف بحياته المليئة بالمغامرات كصياد ذهب وبحار، وبمناصرته القوية للاشتراكية، حيث مزج تجاربه القاسية مع قضايا العمال والطبقة العاملة في أعماله الأدبية مثل "نداء البرية" و"الناب الأبيض". بدأ حياة الفقر في كاليفورنيا، عمل في مهن شاقة، ثم انطلق لكتابة قصص تعكس تجاربه في يوكون أثناء حمى الذهب، محققًا شهرة عالمية وثروة كأحد أوائل الكتاب الروائيين الذين حققوا ذلك من أعمالهم.
مقولة جاك لندن من ترجمة الكاتب عن الإنجليزية.