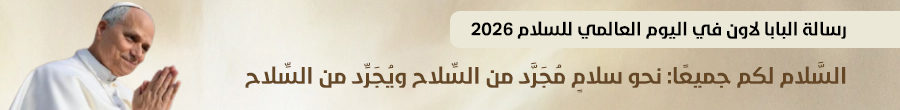موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
رؤية متكاملة لوحدانية الخلاص بيسوع المسيح وفي الكنيسة
مقدمة
يتساءل كثيرون اليوم عن معنى المقولة الشهيرة «لا خلاص خارج الكنيسة» (extra ecclesiam nulla salus)، ودلالتها في العقيدة المسيحية، والتي تشير إلى أن الكنيسة هي الطريق الوحيد والأداة الضرورية لنيل الخلاص. فهل يعتبر الانتماء إلى المسيحية شرطًا لا غنى عنه للخلاص؟ وهل يمكن فهم رحمة الله الشاملة على أنّها تتيح إمكانيةٌ ما للخلاص لمن لم ينتموا إلى الكنيسة؟
هذه التساؤلات تدفعنا إلى التفكير في مصير ملايين البشر أصحاب الإرادة الصالحة الذين لم تصل إليهم البشارة بالإنجيل، فكيف يمكن التوفيق بين هذه الحقيقة الواقعية وبين الرؤية المسيحية لرحمة الله اللامحدودة، التي تشمل البشرية جمعاء؟ من هنا تظهر الحاجة الملحّة إلى فهم المقولة في سياقها التاريخي واللاهوتي، بعيدًا عن التشدد أو التفسير الحرفي الذي قد يحجب المعنى الحقيقي للخلاص وفقًا لإرادة الله الرحيمة.
في التطوّر التاريخي اللاهوتي، كثيرًا ما أُسيء فهم عبارة «لا خلاص خارج الكنيسة»، أو تم تفسيرها بتشدّدٍ إلى حدّ أفقدها الوضوحَ اللازم لفهم معناها ومضمونها العقائدي في إطار التدبير الإلهي للخلاص. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا المقال إلى تقديم تعليم يساعد على استعادة الفهم الصحيح للمقولة، دون التفريط في جوهر الإيمان أو التخلّي عن القناعة المسيحية التي تؤكد ضرورة المعمودية والانتماء للكنيسة كوسيلتين أساسيتين لنيل الخلاص.
وبما أنّ هذه المقولة تمتلك تقليدًا طويلًا في تعليم الكنيسة، وقد أكّدها عدد من المجامع المسكونية والبابوات، يبدو من المناسب أن نبدأ بعرض موجز لتطوّرها التاريخي–اللاهوتي، ليتضح السياق الذي نشأت فيه وكيف فهمها آباء الكنيسة واللاهوتيون، تمهيدًا للانتقال إلى تفسيرها في ضوء تعليم المجمع الفاتيكاني الثاني، ثم تتبع تطوّرها حتى يومنا هذا.
ومن الجدير بالذكر أنّ عبارة «لا خلاص خارج الكنيسة» لا تَرِدُ حرفيًا في نصوص العهد الجديد، لكنها تستند إلى أساس لاهوتي واضح، إذ يعلن العهد الجديد أن الخلاص لا يُنال إلاّ في يسوع المسيح: «فما من اسم آخر تحت السماء وهبه الله للناس نقدر به أن نخلص إلا بيسوع» (أعمال 4: 12). فالمسيح هو الوسيطُ الوحيد للخلاص بين الله والناس (1تي 2: 4–5)، بل هو ذاته «الطريق والحقّ والحياة» (يوحنا 14: 6). ويؤكّد إنجيل مرقس هذا البُعد الخلاصي بقوله: «مَن يؤمن ويتعمّد يخلُص، ومَن لا يؤمن يُهلك» (مرقس 16: 16).
من خلال هذه النصوص، يتّضح أنّ فرادَة الخلاص في المسيح تشكّل الأساس الجوهري للرؤية المسيحية للخلاص، غير أن هذه الفرادة لا تنفي شمولية الخلاص، بل تؤسّسها: فالله «يريد الله أن يخلُص جميع الناس، لأنّ الله واحد، والوسيط بين الله والناس واحد، هو يسوع المسيح» (1 تي 2: 4)، لأن إرادته الخلاصية موجّهة إلى البشرية جمعاء. وهكذا، يظهر أن الانتماء إلى المسيح وإلى الكنيسة يُعد شرطًا للخلاص، مع التأكيد في الوقت نفسه على رحمة الله الشاملة التي تشمل الجميع.
- التطور التاريخي اللاهوتي
عبر تاريخ هذه المقولة، يمكن التمييز بين ثلاث مراحل رئيسة: عصر آباء الكنيسة، والعصور الوسطى، ثم المرحلة الحديثة–المعاصرة. وتتميز كلّ مرحلة بسياقها الفكري والراعوي الخاص. ففي العصر الآبائي، ارتبطت الصيغة أساسًا بمشكلة الهراطقة والمنشقّين الذين تركوا الشركة الكنسية، فكانت تُستخدم للدفاع عن وحدة الكنيسة وضرورتها في مسيرة الخلاص. أمّا في العصور الوسطى، فقد ساد الاعتقاد بأنّ الإنجيل بلغ معظم العالم المعروف آنذاك، مما أفسح المجال أمام ظهور نظريّات حول مصير غير المسيحيين ودينونتهم. وفي العصر الحديث، وخصوصًا بعد اكتشاف أراضٍ جديدة والتعرّف إلى شعوب لم يصلها التبشير المسيحي بعد، برزت الحاجة إلى إعادة قراءة المقولة وتطوير أساس لاهوتي أوسع يفسّر معناها في ضوء الواقع البشري الجديد.
في عصر الآباء الأوائل، تظهر صيغة «لا خلاص خارج الكنيسة» بوضوح للمرة الأولى في كتابات أوريجانوس وقبريانوس القرطاجي. ففي تفسيره الرمزي لحكاية راحاب في الإصحاح الثاني من سفر يشوع، يؤكّد أوريجانوس أنّ «خارج هذا البيت الواحد، أي خارج الكنيسة، لا يخلُص أحد، وأمّا من يخرج منها فهو مسؤول عن هلاكه وموته».
أما القديس قبريانوس، الذي يُنسب إليه صياغة هذه المقولة، فقد عبّر عنها في كتابه «في وحدة الكنيسة» بالعبارات التالية:
- «لا يمكن لأحد أن يكون الله أبا له ما لم تكن الكنيسة أمّا له»؛
- «لا بيت للمؤمنين خارج الكنيسة الواحدة»؛
- «لا يستطيع أن يبقى مع الله مَن لم يشأ أن يبقى في انسجام داخل كنيسة الله»؛
- «خارج الفلك: الطوفان والموت؛ وخارج الكنيسة: الهلاك، فلو استطاع أن ينجو أحد خارج فلك نوح، لاستطاع أن يخلص من هو خارج الكنيسة»،
وقد لخّص قبريانوس هذه القناعات في كتاباته الأخرى بالصيغة التي أصبحت لاحقًا أكثر وضوحًا: «لا خلاص خارج الكنيسة».
ومع الآباء اللاحقين، ولا سيّما القديس أغسطينوس، اكتسبت هذه العبارة معنىً أوسع وأكثر تحديدًا. ففي إحدى عظاته إلى شعب كنيسة قيصرية يقول: «لا يستطيع الإنسان أن ينال الخلاص إلا في الكنيسة الكاثوليكية. فخارج الكنيسة يمكنه أن يحصل على كل شيء ما عدا الخلاص، ولكن في أي مكان آخر لن يجد الخلاص إلا في الكنيسة الكاثوليكية» (الرسالة 6)، ويضيف أيضًا: «كل من انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية، هو محكوم عليه بالغضب الإلهي» (الرسالة 141).
ومع ذلك، فإن هذه المقولة في تعليم الآباء كانت موجّهة أساسًا إلى المسيحيين المعمّدين، لا إلى أولئك الذين لم ينتموا أصلاً إلى الكنيسة. أي أنّها كانت تتعلق بمن انفصلوا طوعًا عن الشركة الكنسية، وانضمّوا إلى جماعات هرطوقية أو منشقة، فقد حرموا أنفسهم من الوسائط الخلاصيّة التي وهبها الربّ لكنيسته. وهذا هو، المعنى الذي قصده الآباء الأوائل من مقولة «لا خلاص خارج الكنيسة». وقد انتقلت هذه الرؤية، التي عبّر عنها كبريانوس وأغسطينوس والعديد من الآباء الأوائل، بشأن خلاص المسيحيّين المنفصلين والمنشقين عن الكنيسة، لتصبح قناعة شائعة بين اللاهوتيّين في العصور الوسطى.
أما في العصور الوسطى، فقد فسّر فالجينسيوس الرسبّي، تلميذ أغسطينوس، هذه الصيغة تفسيرًا أكثر تشدّدًا، فجعل منها نظريّة تنفي إمكانية خلاص جميع غير المؤمنين وغير المعمَّدين، مؤكدًا أن خارج الكنيسة الكاثوليكية لا ينال أحدٌ مغفرة الخطايا؛ بينما داخل الكنيسة الكاثوليكية «الإيمانُ بِالقَلبِ يَقودُ إلى البِرِّ، والشَّهادَةُ بالِّلسانِ تَقودُ إلى الخلاصِ» (رو 10:10)، أما خارجها، فالإيمان الخاطئ لا يقود إلى الخلاص بل إلى العقاب، والاعتراف الزائف بالإيمان لا يؤدي الى الخلاص لمن يعلنه، بل يَلد له الموت. ويضيف: فالجينسيوس قائلًا: «اعلموا بإيمانٍ راسخ، ولا تشكّوا بأي شكل، في أنّ كل شخص معمَّد خارج الكنيسة الكاثوليكية لا يمكنه أن يشترك في الحياة الأبدية، إلا إذا رجع قبل نهاية حياته إلى الكنيسة واندمج فيها».
وقد تبنت السلطة التعليمية في العصور الوسطى تأملات فالجينسيوس وأفكاره مرارًا. فأول نص رسمي يورد فيه هذه الصيغة كان إعلان الايمان للبابا إنّوشنتيوس الثالث الذي طلبه من جماعة الفالديين سنة 1208، والذي ينص على: «لا يستطيع أحد أن يخلُص خارج الكنيسة الواحدة، المقدّسة، الرومانيّة، الكاثوليكية الرسولية» (دنتسنغر792). وفي عام 1215، أعلن المجمع اللاتراني الرابع، في مواجهة الألبيجيين، أنّه: «توجد كنيسة واحدة جامعة للمؤمنين، لا خلاص لأحد خارجًا عنها» (دنتسنغر802). ثم أكّد البابا بونيفاسيوس الثامن هذا التعليم في البراءة البابوية الواحدة المقدسة Unam Sanctam ، سنة 1302، بصيغة أكثر حزمًا: «نُعلن ونقول ونحدد بأنّه من الضرورة المطلقة للخلاص، ولكلّ خليقة بشريّة، أن تخضع للحَبر الروماني» (دنتسنغر875). وأخيرًا، في عام 1442، يؤكّد مجمع فلورنسا المسكوني على نفس المبدأ، قائلاً بإيمانٍ راسخ أنّ «جميع من يعيشون خارج الكنيسة الكاثوليكية، ليس الوثنيين فقط، بل اليهود أيضا، والهراطقة، والمنشقين لا يمكنهم أن يكونوا مشتركين في الحياة الأبدية، ما لم ينضمّوا إلى الكنيسة قبل نهاية حياتهم. ولا يستطيع أحد أن يخلُص، حتّى لو ضحى بدمه في سبيل اسم المسيح، ما لم يثبت في حضن الكنيسة الكاثوليكية ووحدتها» (دنتسنغر1351). وتُصبح صياغة مجمع فلورنسا أكثر وضوحًا إذا أخذنا في الاعتبار سياقها التاريخي. حيث يشير الكاردينال جوزيف راتسنغر إلى أنّ المجمع لم يطرح تعليما أو فكرا خارج سياق اللاهوت، بل كان يسعى إلى رأب الصدع الناجم عن الانقسام بين الشرق والغرب. مع التأكيد على ضرورة استعادة وحدة الكنيسة غير المنقسمة.
وبشكل عام، ينبغي الانتباه إلى أنّ عقلية العصور الوسطى كانت تستند إلى قناعة راسخة بأن العالم بأكمله قد تلقّى البشارة بالإنجيل على يد الكنيسة، وبالتالي فإنّ من يرفض الإنجيل يفعل ذلك عن وعي وإرادة، ويُعتَبَر مسؤولًا عن رفضه. ومع ذلك، لم يخلُ لاهوت تلك الحقبة من محاولات لتخفيف الصيغة الصارمة. فجرى تطوير بعض المفاهيم التي تتيح إمكانية الخلاص والانتماء المباشر إلى الكنيسة المنظورة، فعلى سبيل المثال: معمودية الدم "الاستشهاد"، باعتباره بديلاً عن معمودية الماء. وكذلك معمودية الشوق (votum baptismi)، التي تتيح لمن تعذر عليه نيل سر المعمودية أن يحصل على أثره الخلاصي.
وبالتالي، يمكن تلخيص تفسير العصور الوسطى لهذه الصيغة على النحو التالي: «لا خلاص خارج الكنيسة الكاثوليكيّة لمن يختار البقاء خارجها عن وعي وإدراك».
لاحقا، واجهت الكنيسة واقعًا جديدًا فرضته الاكتشافات الجغرافية الكبرى، حيث اكتشفت شعوبٌ كاملة لم تصلها البشارة والكرازة المسيحية ولم تنل سرّ المعموديّة، أي نشأوا خارج الكنيسة المنظورة extra Ecclesiam visibilem. وقد دفع هذا الواقع اللاهوت والتعليم الكنسي إلى البحث تدريجيًا عن إمكانية الخلاص حتى لمن لم ينتموا فعليًّا إلى الكنيسة. فإلى جانب مفهومي معمودية الشوق ومعموديّة الاستشهاد، برز في تلك الفترة أيضًا موضوع الجهل المطلق "المُطبق" (ignorantia invincibilis)، باعتباره عاملًا يمكن أن يفتح باب الخلاص لمن لم يتلقَّوا الإيمان المسيحي دون إرادتهم.
وفي هذا السياق التاريخي، اتخذت الكنيسة مواقف مهمّة ضدّ التيّار الجانسيني، ورفضت تشدّده المفرط في مقاربة النعمة والخلاص. ففي عام 1653، أدان البابا إنوشينتيوس العاشر بعض مقولات جانسينيوس في شأن النعمة، قائلا: «من يقول إن المسيح مات أو سفك دمه من أجل جميع البشر دون استثناء، فهو من أنصاف البيلاجييين» (دنتسنغر2005). ثم أدان البابا كليمنضوس الحادي عشر عام 1713 الجانسيني باسكيه كينيل حيث أكد أنّ «خارج الكنيسة لا تمنح أي نعمة» (دنتسنغر2429). بهذه المواقف، اتخذت السلطة التعليمية موقفًا ضد الأوغسطينية المتشدّدة والمبالغ فيها بشأن إمكانية الخلاص خارج حدود الكنيسة المنظورة، وساهمت في بلورة فهمٍ أكثر اتساعًا لعمل نعمة الله الخلاصيّة في العالم.
وفي مراحل لاحقة، واصلت الكنيسة تبني هذه المقولة مع إدخال بعض التوضيحات الجوهريّة. ففي عام 1854، رفض البابا بيوس التاسع النزعة اللامبالية (indifferentismo) التي ترى أنّ كل دين يشكّل طريقًا إلى الخلاص، مؤكّدًا أن «خارج الكنيسة الرسولية الرومانية لا يمكن أن يخلص أحد»، لكنه أضاف في الوقت نفسه أنه لا يجوز «وضع حدود لرحمة الله اللامتناهية، وأنّه يجب الإيمان بأنّ الذين يعيشون في جهلٍ مُطبق ومطلق للديانة الحقيقية، لن يقع عليهم في نظر الرب أيّ ذنب في ذلك». (دنتسنغر2865)، وفي الرسالة العامة إلى أساقفة ايطاليا Quanto conficiamur عام 1863، عمّق البابا بيوس التاسع هذا التوجّه الإيجابي، موضحًا أنّ «أولئك الذين يعيشون في جهل مُطبق تجاه دياناتنا الجزيلة القداسة، والذين يلتزمون بعناية الشريعة الطبيعيّة وفرائضها التي كتبها الله في قلوب الجميع، ويكونون مستعدين لإطاعة الله، ويعيشون حياة مستقيمة وصالحة، يستطيعون بعون النور الإلهي ونعمته، نيل الحياةَ الأبديّة» (دنتسنغر2866). وشدّد البابا أنّ هذا الخلاص لا يتحقّق بفضل ديانة أخرى، بل بفضل نعمة الله العاملة في ضمير الإنسان.
أخيرا في اللاهوت المعاصر، تُعدّ الرسالة العامة جسد المسيح السري للبابا بيوس الثاني عشر (عام 1943)، المرجعية الأساسية، إذ يشير البابا إلى: «أولئك الذين لا ينتمون إلى البنية المنظورة للكنيسة»، داعيًا إياهم إلى «بذل كلَّ جهدٍ للخروج من حالة عدم اليقين بشأن خلاصهم الابدي. فحتى إذا كانوا، بشيء من الرغبة أو التمني اللاواعي، مُعدين للارتباط بجسد الفادي السري، إلا أنّهم محرومون من الكثير من مساعدات الله وإنعاماته السماوية، التي لا يمكن التمتع بها إلا في الكنيسة الكاثوليكية» (دنتسنغر3821). لا يعيد البابا ذكر الصياغة التقليدية لا خلاص خارج الكنيسة، ومع ذلك، فهو يتحدث عن أشخاصٍ «موجَّهين» نحو الجسد السري للمسيح بفضل رغبة أو نيّة ضمنية غير واعية، وهي حالة قد تؤهّلهم لنعمة الخلاص حتى دون الانتماء الفعلي إلى الكنيسة المنظورة.
يقدّم بذلك البابا بيوس الثاني عشر توضيحات أساسية وحاسمة فيما يتعلق بالخلاص لغير المنتمين الى الكنيسة الكاثوليكية، حيث يبرز عنصرٌ سلبي واحد وهو الجهل المطلق؛ إلى جانب ثلاثة عناصر إيجابية هي: الرغبة أو النية الضمنية، والمحبّة الكاملة، والإيمان الفائق للطبيعة. وبفضل هذه العناصر، يُمكن للإنسان بلوغ الخلاص حتى دون الانضمام إلى الكنيسة المنظورة، لأنّها، في واقع الأمر، «توجِّه» الإنسان نحو الكنيسة و«تُوحِّده» بها. والمقصود هنا، في سياق تعليم البابا، هم المسيحيون غير الكاثوليك أساسًا، لا غير المؤمنين بالمسيح. وفي الوقت نفسه، رفض البابا موقفَ المتشدّدين الذين يستبعدون الخلاص عن كلّ من لا ينتمي إلى الكنيسة انتماءً كاملاً، كما رفض أيضًا من يزعمون إمكانية نيل الخلاص عبر دينٍ آخر.
خلاصة الأمر: إنّ التقليد الكاثوليكي، عبر تاريخه، ظلّ متمسّكًا بالرؤية الاكليزولوجية المركزية لمقولة «لا خلاص خارج الكنيسة»، مؤكدًا أنّ العلاقة بين الكنيسة والخلاص وثيقة للغاية. وأن المسار الاعتيادي للخلاص يمرّ عبر الكنيسة والأسرار المقدسة، وقد رفض الآباء واللاهوتيّون، وكذلك السلطة التعليمية في مختلف العصور، كلَّ أشكال اللامبالاة الدينية والنسبية العقائديّة، وحاربوها بوضوح. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أنّ الخلاص خارج نطاق الكنيسة المنظورة، مٌقدم لجميع البشر، لان «الجميع مدعوون بلا استثناء بنعمة الله الى الخلاص» (نور الامم13)، وهذا يشمل أولئك الذين يجهلون الإنجيل ولكنّهم يعيشون، ضمن تقاليدهم الدينيّة ودياناتهم المختلفة، الإيمان والمحبة بصدق. وتُعدّ هذه الحالة طريقًا استثنائيًا للخلاص، يتجلى فيه عمل النعمة خارج الحدود المرئية للكنيسة، دون أن يلغي ضرورة الكنيسة كوسيط أصيل وضعه المسيح للخلاص.
- تعليم المجمع الفاتيكاني الثاني
تُقدّم نصوص المجمع الفاتيكاني الثاني العلاقة فهمًا متجددًا للعلاقة بين الكنيسة والخلاص من خلال تبنّي مفهومَيْ الكنيسة «شعب الله» والكنيسة «سرّ الخلاص»، وذلك ضمن إطار يركّز على البعد الكرستولوجي أكثر من التركيز على البعد الإكليزولوجي التقليدي. ويتيح هذا التوجّه الاعتراف بوجود عناصر من الحقّ والخير في الديانات الأخرى، دون أن ينتقص ذلك الدور الفريد للكنيسة في سرّ الخلاص.
وقد اختار محرّرو النصوص المجمعيّة إعادة صياغة مقولة «لا خلاص خارج الكنيسة» بصيغة إيجابية؛ إذ يؤكّد المجمع أنّ «الكنيسة في مسيرتها على الارض ضرورية للخلاص، مستنداً في ذلك الى الكتاب المقدس والتقليد الرسولي». والسبب الجوهري في ذلك هو أنّ المسيح وحده هو وسيط الخلاص وطريقه الأوحد: «فهو حاضر بيننا في جسده، أي الكنيسة. وقد شدّد الربّ بوضوح على ضرورة الايمان والعماد (راجع مر 16/16؛ يو 3 /5)»، ومن ثمّ فإن اتحاد الكنيسة بالمسيح يجعلها بدورها ضرورية للخلاص. ولذلك يعلن النصّ المجمعي على: «ضرورة الكنيسة للخلاص التي يدخلها البشر بالمعمودية باعتباره الباب. ولن يستطيع أن يخلُص أولئك الذين يرفضون إمّا الدخول في الكنيسة الكاثوليكيّة أو البقاء فيها، بينما يعلَمون أنّ الله أسّسها بيسوع المسيح وجعلها ضرورية للخلاص» (نور الأمم 14).
في ضوء هذا التعليم، لم يَعُد التأكيد على «ضرورة الكنيسة للخلاص» يعني أنّ الانتماء إلى الكنيسة المنظورة فقط هو الشرطُ الضروري لتحقيق الخلاص؛ بل المقصود هو أنّ الكنيسة، بوصفها «علامة وأداة لخلاص البشر أجمعين» (نور الأمم 1)، مرتبطة ارتباطًا جوهريًا بسرّ الخلاص ذاته. فحيثما يكون المسيح، تكون الكنيسة، ولا يمكن الفصل بين المسيح وجسده. وبالتالي، فكلّ إنسان ينال الخلاص بنعمة المسيح، يناله في الوقت نفسه من خلال الكنيسة، سواء أدرك ذلك أم لم يدركه.
وانطلاقًا من هذا الفهم، تناولت التعاليم الكنسية والفكر اللاهوتي في مرحلة ما بعد المجمع هذا الموضوع بوصفه مبدأً لم يعد يتعلّق بتحديد الأشخاص الذين ينالون الخلاص بقدر ما يركّز على كيفية تحقيق الخلاص ووسائله. وهكذا انتقل السؤال الجوهريّ بعد المجمع من التساؤل حول: «مَن هم الذين يخلُصون؟»، إلى: «كيف يتحقق الخلاص في حياة الذين يخلُصون؟»، وبذلك أصبح الاهتمام منصبًّا على طرق ووسائل عمل الله الخلاصي، أكثر من التركيز على تحديد مَن ينال الخلاص. فاللاهوت بات يتأمل في كيفيّة بلوغ البشر إلى ملء الخلاص بيسوع المسيح، من خلال الكنيسة التي جعلها الله أداةً لهذا العمل الإلهي.
ويلاحظ أيضًا أنّ المجمع يستعيد التعليم الذي قدّمه البابا بيوس التاسع والبابا بيوس الثاني عشر، حين يؤكّد أنّ الذين: «بغير خطأ منهم يجهلون إنجيل المسيح وكنيسته، ومع ذلك يفتشون عن الله بنيَّة صادقة، ويجتهدون في تتميم ارادته بأعمالهم، كما يعرفونها من خلال إملاءات ضميرهم، يمكنهم هم أيضاً أن يبلغوا الى الخلاص الأبدي» (نور الأمم 16). وهذا يوضح أنّ نعمة الله لا تنحصر بالمنتمين ظاهريًا إلى الكنيسة، بل تُمنح لكلّ من يفتح قلبه للحقّ ويجتهد في عيشه، حتى إن كان يجهل الكنيسة جهلاً غير مسؤول عنه.
والجديد في نص المجمع هو اعترافه بإمكانية أن يجد أتباع الأديان والتقاليد غير المسيحية طريقًا لتلقي الخلاص، دون أن يلغي هذا الاعتراف الوساطة الفريدة للمسيح ولا من دور الكنيسة كوسيلةٍ خلاصية أصيلة. فتشير الفقرة 16 من وثيقة نور الأمم إلى أنّ: «الذين لم يقبلوا الانجيل بعد، فإنهم متجهون نحو شعب الله بطرق شتى». وعلى هذا الأساس، يُطبَّق مبدأ “الدعوة الشاملة” نحو الخلاص- أي ان جميع البشر "مدعوون" بلا استثناء إلى نيل الخلاص بنعمة الله، بما في ذلك اليهود، والمسلمين، وأتباع الديانات الأخرى، والملحدين.
وتبقى الشروط الثلاثة الرئيسة، التي سبق أن حدّدها التقليد الكنسي، جوهرية وأساسية لتحقيق هذه الإمكانيّة الاستثنائية للخلاص خارج الانتماء الظاهري للكنيسة:
1. الجهل بإنجيل المسيح والكنيسة: أي الجهل المطبق
2. السعي الصادق إلى الله.
3. اتباع مقتضيات الضمير وأوامره في الحياة.
إلا أنّ المجمع يؤكد، في الوقت ذاته وبلا أي شكٍّ أو التباس، أنّ الخلاص لا يأتي إلا بيسوع المسيح وحده. ففي نص قرار في نشاط الكنيسة الإرسالي، فقرة7، يُعلن: «إن دواعي النشاط الإرسالي كامنة في إرادة الله، "الذي يريد أنّ جميع الناس يَخلُصون ويبلغون إلى معرفة الحق، لأن الله واحد، والوسيط بين الله والناس واحدٌ، الإنسان يسوع المسيح، الذي بذَل نفسَه فداءً عن الجميع" (اتي2: 4- 5)، "وما من خلاصٍ بأحدٍ غيره" (أع4: 12). فيجب إذاً أن يُـقبِلَ عليه الجميع كما يتجلَّى في كرازةِ الكنيسة، وأن ينضمّوا بالمعمودية إليه وإلى الكنيسة التي هي جسدُه».
ومن ناحية أخرى، يقرّ المجمع بأنّ جميع البشر، حتى غير المؤمنين منهم، يمكنهم أن يبلغوا الخلاص؛ «إذ إنّ العناية الإلهيّة لا تمنع المعونات الضروريّة للخلاص، لأولئك الذين بدون ذنبٍ منهم، لم يتوصلوا بعد إلى معرفة الله الواضحة والاعتراف به، لكنّهم، غير منفصلين عن نعمة الله، أذ يجتهدون في عيش حياة صالحة ويسعون للسير في سيرة مستقيمة بمساعدة النعمة الالهية. فكلّ ما يمكن أن يوجد لديهم من خير وحق، تعتبره الكنيسة استعدادًا إنجيليًا وتهيئةً لقبول البشارة بالإنجيل، وعطيّةً من ذاك الذي ينير كلّ إنسان لكي ينال الحياة في النهاية» (نور الأمم 16).
وفي حالة غير المؤمنين، تقوم إمكانية الخلاص على عنصرين أساسيين:
1. أن يكون عدم إيمانهم (أو إلحادهم) ناتجًا عن جهلٍ غير مسؤول عنه، وليس عن تقصيرٍ منهم أو رفضٍ واعٍ للحقّ؛
2. أن يجتهدوا في عيش حياة مستقيمة وصالحة، متعاونين مع النعمة الإلهية التي تعمل في ضمائرهم.
أمّا الإضافة الجوهريّة التي يقدّمه المجمع الفاتيكاني الثاني فتكمن في أنّ حقيقة الخلاص لم تعد قائمة على رغبة ذاتية غير واعية، كما أشارت إليها الرسالة البابوية جسد المسيح السري، بل أصبحت ترتكز على الإرادة الخلاصيّة الشاملة لله، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوساطة المسيح الوحيدة:« الله يريد أن جميع الناس يخلصون ويبلغون إلى معرفة الحق، لأن الله واحد، والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع، الذي بذل نفسه فداء عن الجميع» (1 تي 2: 4-6)، كما ترتبط هذه الوساطة بتاريخ الخلاص الشامل الذي يمتدّ إلى جميع البشر:« لا يستطيع البشر إذا أن يدخلوا في شركة مع الله إلاّ بالمسيح وبعمل الروح. إن فرادة وساطته الوحيدة وشموليتها أبعد من أن تكون حاجزا على الطريق الذي يقود إلى الله، الطريق الذي رسمه الله بنفسه، والمسيح يعرفه تماما. ذلك لا ينفي اسهام وساطات أخرى من أشكال ونظم مختلفة. ولكن هذه لا تستمد معناها وقيمتها إلا من فرادة وساطة يسوع المسيح، ولا يجوز اعتبارها متساوية أو مكملة لها» (رسالة الفادي، 5). وتتميز وساطة يسوع المسيح بأنها فريدة، شاملة، حاسمة، وكاملة، ومبنية على سر ذبيحته. فالخلاص الذي أتى به يسوع يشمل جميع البشر، لأنه يجسد العمل الإلهي الكامل والنهائي في سبيل نيل الحياة الأبدية.
ولفهم تعليم المجمع الفاتيكانيّ الثاني على نحوٍ صحيح، ينبغي أن نضع في اعتبارنا أنّه لا ينطلق من رغبةٍ ذاتيّة خلاصية لدى الإنسان، بل من التدبير الخلاصيّ الموضوعيّ الذي يَجد كماله في يسوع المسيح: الذي منه وبه وفيه كلّ شيء، «لأنَّ اللهَ شاءَ أنْ يَحِلَّ فيهِ الملءُ كُلُّهُ، وأنْ يُصالِحَ بِه كُلَّ شيءٍ في الأرضِ كما في السَّماواتِ» (كو1: 17). وبناءً على هذا التدبير، يؤكّد المجمع على الأهمية الخلاصيّة الشاملة ليسوع المسيح، ولا ينظر إلى الديانات الأخرى بوصفها طرقًا موازية أو بديلة للخلاص. فحتى خلاص غير المسيحيّين هو خلاصٌ بيسوع المسيح وفي يسوع المسيح. كما أنّ المجمع لا يُعلّم بوجود فداءٍ شاملٍ للجميع يتحقق تلقائيًا لكل البشر. فالله يريد خلاص جميع البشر؛ غير أنّ خلاص كل شخص يظلّ مرتبطًا باستجابته الحرة لنعمة الله، كما يدركها ويعيشها في إطار ضميره وظروف حياته. وبالتالي، فإنّ تعليم المجمع وعقيدته لا يمتّ بأيّ صلة إلى أشكال النسبية الخلاصية، أو اللامبالاة الدينية، أو القول بفداء كوني شامل.
باختصار: إنّ المجمع الفاتيكانيّ الثاني لا يُلغي الصيغة التقليدية: «لا خلاص خارج الكنيسة»، بل يعيد تفسيرها في إطارٍ تاريخيّ–خلاصيّ شامل، ذي طابعٍ كريستولوجيّ وبُعدٍ ابنفماتولوجي (أي البعد المرتبط بعمل الروح القدس). ويجب الاشارة إلى أنّ تفسير المجمع يستند إلى اللاهوت الآبائيّ، وأيضا المدرسيّ، إذ يرى الكنيسةَ واقعًا فاعلاً في العالم، ويُدرك الكنيسة المنظورة بوصفها علامةً إسكاتولوجيّة تُرفع بين الأمم، وأداةً في هذه المسيرة التاريخيّة الشاملة للخلاص.
ويُوضح المجمع أنّ الخلاص، سواء أُدرك صراحةً أو ضِمنيًّا، يمرّ دائمًا عبر وساطة الكنيسة، إذ لا خلاصَ آخر قُدِّم للبشر سوى خلاص “المسيح الشامل، رأس الكنيسة وجسده. وبذلك تصبح الكنيسة علامة وأداة الخلاص الموجهة إلى العالم أجمع، وهي الصيغة التي حلت محل المقولة التقليدية: «لا خلاص خارج الكنيسة» دون أن تنقض جوهرها..
بهذا المعنى يمكن القول إنّ الكنيسة ضرورية لخلاص العالم، وليس المقصود بعبارة «لا خلاص خارج الكنيسة» أنّ الذين لا ينتمون إلى الكنيسة محرومون من الخلاص، بل أنّ الخلاص يصل إلى جميع البشر من الله، بواسطة الكنيسة، كونها أداة للخلاص.
خاتمة
إنّ الخلاص مُقدَّم لجميع البشر، غير أنّه «يُمنَح دومًا بواسطة المسيح وفي الروح القدس، وفي علاقة أسراريّة بالكنيسة» (الرب يسوع Dominus Iesus، 21)، ولهذا السبب، «اعتبار الكنيسة أحدَ طرق الخلاص، بين طرقٍ أخرى، يُعدّ مناقضًا للإيمان الكاثوليكي، إذ تصبح الأديان آنذاك مكمّلة للكنيسة أو حتى مساوية لها جوهرياً» (الرب يسوع، 21). ومع أنّ الديانات الأخرى والتقاليد الدينية تحتوي على عناصر من الحق والخير، ويمكن اعتبارها تهيئة للإعداد للإنجيل والانفتاح على العمل الإلهي، إلا أنّه «لا يمكن أن يُنسب اليها ما تتميز به الاسرار المسيحية من مصدر إلهي وفعالية خلاصيه بقوة الفعل ذاته ex opere operato » (الرب يسوع، 21). ومع مجيء يسوع المسيح المخلّص، أصبحت الكنيسة التي أسسها أداة الخلاص للبشرية جمعاء. وهذه الحقيقة الإيمانية لا تقلل من الاحترام الصادق الذي تكنّه الكنيسة تجاه ديانات العالم، لكنها في الوقت نفسه «ترفض بشكل قاطع عقلية اللامبالاة القائمة على النسبيّة الدينيّة، التي تؤدّي إلى الاعتقاد بأنّ كل الأديان متساوية» (الرب يسوع، 22).
لقد عرّف المجمع الفاتيكانيّ الثاني الكنيسة بأنّها سرِّ الخلاص الشامل، أنّه «بواسطة كنيسة المسيح الكاثوليكية وحدها، التي هي الوسيلة الشاملة للخلاص، يمكن الوصول الى كمال الوسائل الخلاصية بأكملها» (قرار في الحركة المسكونية3؛ نور الأمم 48). وأيضا يجب التأكيد على إنّ الاعتراف بإمكانية الخلاص لغير المسيحيين لا يعني البتّة اعتبار الأديان غير المسيحيّة كحقائق موضوعية ذات فاعليّة خلاصيّة، ولا النظر إليها بوصفها طرقًا أو سُبُل خلاصٍ موازية. كما أنّه لا يجوز قلب الصيغة التقليديّة بالقول إنّ «خارج الكنيسة يوجد خلاص» (extra ecclesiam salus ).
صحيح أنّ المجمع الفاتيكاني الثاني لم يقدّم توضيحًا نهائيًّا أو حسمًا كاملاً للمسائل المعقدة والشائكة المتعلّقة بعلاقة المسيحية بالأديان الأخرى، غير أنّه وضع مبدأً جوهريًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه: فإذا كانت نصوص المجمع تؤكد أنّ الكنيسة وحدها هي الوسيلة الوحيدة والضرورية للخلاص، فلا يمكن حينئذٍ نسب أو إسناد أيّ ضرورة خلاصيّة للأديان غير المسيحية؛ وإلا لكان ذلك تناقضًا صريحًا مع تعاليم المجمع نفسه.
إنّ المخلّص يفيض قوّة نعمته وفعاليّته حتّى خارج حدود الكنيسة؛ غير أنّ هذه النعم والعطايا الخلاصيّة موجودة وحاضرة دائمًا في الكنيسة التي أسّسها المسيح، أي أنّ النعمة لا تُمنح خارج الكنيسة بمعزل عنها. فالكنيسة تبقى سرّ الخلاص الشامل، الذي تنبع منه النعمة، ومن خلالها تُعطى للإنسان.
ومن هذا المنطق يوكد تعليم الكنيسة الكاثوليكية على أن يسوع المسيح هو ابن الله، والرب، والمخلص، الذي بتجسده وموته وقيامته أتمّ تاريخ الخلاص، الذي هو كماله ومحوره. ونعترف مع بطرس الرسول «لا خلاص إلا بيسوع، فما من اسم آخر تحت السماء وهبه الله للناس نقدر به أن نخلص» (أع4 :12). ان مشيئة الله الخلاصية الشاملة لجميع البشر، قد تجلت وتحققت مرة واحدة وبشكل نهائي في سرّ تجسّد ابن الله. ومع مجيء يسوع المسيح المخلّص، أراد الله أن تكون الكنيسة التي أسسها أداة الخلاص للبشرية جمعاء. وهذا يعني أنّ الكنيسة الكاثوليكية لا تنكر إمكانية الخلاص على غير المسيحيين، لكنها تشير بوضوح إلى المصدر الوحيد والأخير للخلاص، أي المسيح، الذي فيه اتحد الله بالإنسان. ويمنح الله النور للجميع بما يتلاءم مع حالتهم الداخلية وظروفهم، ويمنحهم النعمة الخلاصية بطرق يعرفها هو وحده.