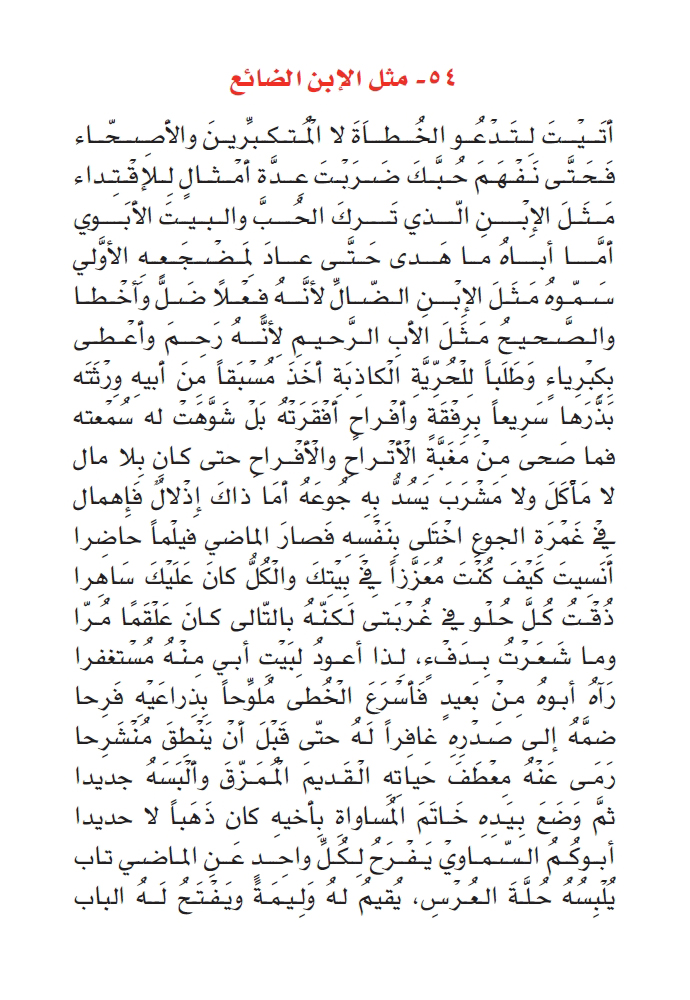موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
يكون فرح كبير في السماء لخاطئ واحد يتوب

الأب منويل بدر - الأردن
الأحد الرابع والعشرون (الإنجيل بو 15: 1-10)
هذا المثل المسمّى بمثل الابن الضائع، وآخرون يسمُّونه مثل الأب الرّحوم، هو من أجمل وأشهر الأمثال، تجاه الخطأة والجُباة والعشّارين، الّذين كانوا مرذولين من الشعب، فجالسهم وأكل معهم ودعاهم ليتبعوه، فهي تكشف لنا قلب الله وحنانه على البشر، إذ هو لا يترك خروفاّ واحداً يضيع، إذ له قلب خاص للخطأة، وهذا يعني لكلِّ واحدٍ منّا، إذ كما يقول بولس: كلّنا أخطأنا في آدم، لكن برجل واحد هو المسيح، تعود لنا النّعمة. إنَّ الله لا يُسّرّ، لا بقصاص ولا بموت الخاطئ، بل يقول لنا إنجيل اليوم، هو يفرح بكلِّ خاطئٍ واحدٍ يتوب، أكثر من 99 لا يحتاجون إلى التوبة. هذا الإنجيل مذكور فقط في لوقا، وتستعمله الكنيسة مرارا وتكراراً في احتفالاتها الدينية العديدة.
عندما أعطى يسوع هذا المثل، كانت علاقتُه مع الفريسيين والكتبة غير متأزِمة بعد، ولم يكونوا بعد قد رفضوه. أمّا يسوع فكان باشر بإثارتهم، بحيث راح يُعامِلُ المطرودين والمرذولين من الشعب بشكل غير معاملة الفريسيين لهم، بل راح يقبلهم، يُجالسهم، يأكل معهم، يغفر لهم ماضيَهم. الفريسيّون والكتبة ما كانوا يقدرون التّخلي عن ياءٍ أو نقطةٍ في شريعة موسى، وها ابن يوسف النجّار، من مدينة الناصرة، لا يُراعي هذي الشريعة اهتماما، بل يتكلّم عن الله كأنّه يعرفه. يُبشِّر بملكوت جديد أسماه ملكوتَ الله أبيه، بل يدّعي أنّه ابن الله. بعكس الفريسيّين، الّذين كانوا يخافون حتى من لفظ كلمة إلههم. والآن يحكي هذه القصة، التي يذهب فيها إلى أبعد ما كانوا يتصوّرون، فهو ينتقد معلِّمي الشعب مباشرة وشخصيّاً. فماذا كان يقصد يسوع أن يقوله لهؤلاء، بل ولنا؟
في بداية كرازته طمأن يسوع ُهؤلاءَ المعلِّمين قائلا: لا تخافوا، إني ما أتيت لأَنْقُض الشّريعة والأنبياء، بل لأُتمِّم. إذن هو سيأتي بشيء جديد يُميِّزُه عمّا سبقه (متى 17:5). أوّلها أنّه بتأسيسه ديانته الجديدة، ما أراد تقسيم المنتمين إليها إلى طبقتين: الرئاسة والمرؤوسين، أو الصّالحين وغير الصّالحين. بينما الفريسيّون فكانوا يعتبرون أنفسَهم نُخبةَ الشّعب. أتباعهم كانوا فقط الأصحاء، بينما المرضى والمُعوقين والخطأة، فما كان لهم الحق بالبقاء فيها، بل كانوا يُطردون منها، بل واعتبروا الجديد، الّذي أدخله يسوع معاكسا ومنافياً لاعتقادهم، فبدأت المناوشات بينه وبينهم، والّذين بالتّالي طالبوا بموته وحصلوا على ذلك
مثل يسوع اليوم هو واقعي، لا تحريف فيه لا ولا عليه، يحتوي الموقفين: موقف الفريسيّين القديم، وموقفه الجديد. هذه الحالة نعيشها بل تعيشها كلُّ عائلة، عندما يبلغ الأولاد فيها فترة المراهقة، حيث تبدأ أيضا فترة التفتيش عن الحياة الحرّة، دون تدخّل أو مراقبة الأهل، لأنّهم يعاتبونهم بقولهم: أنتم لا تزالون تُعاملوني كطفل غريب . يريد أن يترك فندق الأم بأيِّ ثمن، حتى وإن اضطرّ للسكنى في العراء. إنَّ طلب الحرّية متأصِّلٌ في كلِّ نفس. خاصة عند بداية المراهقة. فالمراهقة، سواء للفتى أو للفتاة، هي أصعب مرحلة في الحياة، وهي مؤلمة، سواء للأهل أو أيضا للأولاد، إذ الشاب الثائر لا خِبرة له بعد في الحياة يعتمد عليها، ولا يفهم معنى المسؤولية، فغالباً ما ينزلق في الاتجاه المعاكس، أي بتذوّق ويُجمٍّع الخبرات السّيّئة، التي لا تجلب السّعادة بل التّعاسة. وهي أيضا حقبة صعبة للأهل بالذّات، إذ هم يحملون هموم نجاح أو فشل أولادهم، ويروحون يلومون أنفسهم ويتساءلون، إذا ما هم أخطأوا في تربية أولادهم، فيعودوا في أفكارهم كفي فيلم إلى الوراء ليجدوا، إن كان صدر منهم أي خطأٍ أو تقصير ليلوموا أنفسهم على ذلك. وبعد الرحيل لا يستريح لهم بال، كالأب في هذا المثل، فهو قلباً وقالباً مع ابنه البعيد، أبقى دفّة الباب فاتحة له. هذا وإذا به فعلاَ يراه عائداُ من بعيد، فلوّح له بيديه كي يُسرع الخُطى. ألم يفعل الله هكذا مع آدم في الفردوس، فهو، أي الله الآب، نزل يفتّش عن آدم: - أدم! أين أنت؟ قالوا، حتى العصفور يعود دائما إلى العش الّذي وُلدَ فيه، فكم بالحري الإنسان، فهو لا ينسى جوّ الطّفولة، الّذي عاش فيه مُدلّلاُ محبوباً. في الغربة لا يشعر الإنسان بالراحة. إذ أجمل سكنى، يجد الإنسان فيها الاطمئنان، هي داخل جدران البيت الأبوي، لذا يعود الأولاد دوما إلى هذا البيت، حتى وإن كان لهم هم أيضاً بيتُهم الخاص.
في يسوع نكتشف صُوراً عديدة عن الله. منها صورة الآب الرحوم مع ابنه الّذي ترك البيت الأبوي. فما أظهر يسوع حناناً ورقّة قلب الله ومحبّته مثل في هذه القصّة، التي يسمّيها القديس أوغسطينوس الإنجيل في الإنجيل. فالابن الضائع لا يُحضر معه سوى قزازة كحول وثوباً مُمزّقاً والأمل بعفو والده. وهذه تُهدى له، إذ والده يُعانقه ويقبّله، ولا يُسمعه أية ملامة او شكوى أو عتابـ، بل مغفرة ومحبة، وهكذا يجد الابن الضائع ما فتّش عنه دائما، أي قلبا. فهذه الهديّة لا تغيب عن باله، إذ هو يعرف الآن، ما هو الحب والرحمة، التي لا تعرف حدّاً او حاجزاً. في الضيق يعرف الإنسان مباشرة من هو صديقه ومن هو عدوّه. اذ كما يقول المثل: الصَّديق في الضيق! هذا ووجه الأب المسامح يبرز في هذا المثل الفريد.
رآه أبوه من بعيد. نعم رأى ابنه الّذي كان ضائعا، لكن لله الآب لا يوجد إنسانٌ ضائع، بل عينه على كلِّ إنسان (كلّهم جاءوا إليه فتذمّر الفريسيّون لو 1:15) فقد جاء ليفتّش عن الضائعين ويخلِّصهم. وأسرع لملاقاته، رغم أنّه عرف في قعر نفسه، عن حياة هذا افبن الفاشلة الّتي وراءه، مُقارنة بحياة ابنه الأصغر، الّذي بقي عنده في البيت. لكنّه يُقابله لا بالسخط عليه، لا ولا بالغضب، بل بالحنان الأبوي، من بعد ما كان الأب يحلم لابنه بهذا الموقف، أي موقف التّوبة والرّجوع إلى حضن العائلة، لذا كان فرحه عظيما، عندما دخل ابنه عتبة البيت التي خرج منها. خطوة تستأهل الفرح الكبير الّذي أمر به الأب والاحتفال الكبير الذي أمر الخدام بإقامته: لأنَّ ابني هذا كان ضائعاُ فوُجِد، وكان ميتاً فعاش. هذا المثل أتبعه يسوع بمثلين متشابهين: مثل الخروف الضال ومثل الدراخما المفقود. ثلاثتها بالتالي تعني، كم الله يفرح برجوع الخطأة إليه. فهو كلُّه رحمة: "رحمة أريد لا ذبيحة". فالمسيحي يجب أن يكون رسولا للرحمة، حتى يفهَمَ العالمُ ما في قلب الله. كونوا رحماء كما أن أباكم السّماوي رحيم.
على زمان يسوع ما كان هناك من ملاعب للأطفال، كما في أوروبا، مُحاطة بسور يحميهم من المخاطر الخارجيّة حيث البلديات تهتم بتهيئتها وتأثيثِها بألعاب بشكل يلائم الأطفال. فمنها المراجيح ومنها دَرَجات التّزلِّق والقفز على الرمل، مزروعة بالأعشاب الناعمة، حتى إذا سقط طفل لا يحدث له أي سوء أو ضرر. كما وهناك مقاعد بُنوك للجلوس قريبة، تجلس عليها الأمّهات يتبادلن الحديث وعيونهن شاخصاتٌ ساهراتٌ على أولادِهن. كما والأولاد لا يغفلون عن رمي الأنظار إلى أمّهاتهن. فما أن يحدث لهم شيء حتى يسرعون إليهن ويرتمون في أحضانهن، طلباً للتعزية. فيشعرون أنفسهم محميّين وفي أمان تحت أنظار أمّهاتهن السّاهرة.
إن هذا فعلا هو تفكير يسوع في هذا المثال الحي. فهو يريد أن يقول لنا، تماما كما أن الأم تعتني بمراقبة ابنها على ملعب الأطفال، هكذا يعتني الله فينا، صغارا وكبارا على مسرح العالم. هو يراقبنا لا ليَمسك علينا مماسك ومخالفات، كمراقب شرطي السّير، بل هو يُلقي على كلٍّ منّا نظرة عطفٍ وحب، دائماً جاهزاً ليُعزّينا، وينهضنا من عثراتنا، لنبدأ حياة جديدة معه. إن رحمة الله أوسع من قلبنا، الّذي يوبَّخنا ويشكونا. رحمة الله تخلق فينا قلباً جديداً، بشرط أن نتواضع ونُقِرَّ بخَطانا وفشلِنا أمامه: يا أبتِ! لقد خطئتُ أمامكَ وإلى السّماء.
في رواية Solschenizyn : "مركز السّرطان" يتساءل المقيمون في العيادة، ممّا يعيش الناس؟ من العناية بنا، قال أحدهم. من حبي وحنيني لوطني، قال ثاني. من الاشتراك بالمصالح العامة، قال ثالث. لكن السائل، وعلى نصيحة من تولستوي، أجاب: نعيش من المحبّة. نعم فكمسيحيّين، نحن نعيش بلا شكٍّ من محبّة الله لنا، والّتي لولاها، لما كان من رحمة ولا تسامح ولا غفران للخطيئة. ليس هم الأصحاء الّذين يحتاجون إلى طبيب. ويسوع هو طبيب كلِّ مريض منّا. آمين