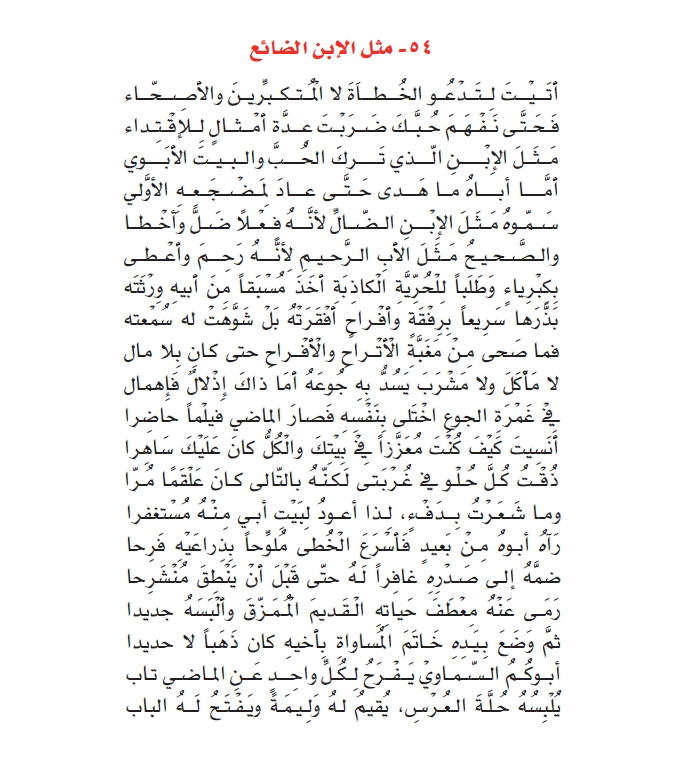موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
قصة الأب الرّحوم

الأب منويل بدر - الأردن
الأحد الرابع للصوم (الإنجيل لو 15: 1-3+11-24)
القصة المعروفة تحت اسم: الابن الضائع
والأصح يجب تسميتها: قصة الأب الرّحوم
في أي عائلة لا تحدث هذه القصة، التي سمعناها، عن الشاب الّذي طالب بالحرّية والاستقلال عن أهله. بإرادته الخاصة، أحبَّ التّخلي عن السكنى في القفص الذهبي، لكسب خبرة جديدة في الحياة وللحياة. من لا يخطر على باله بهذا الصّدد، مطالبة الأمير هاري الإنجليزي التخلي عن كل الشّرف الذي كان حاصلا عليه في قلب العائلة المالكة في لندن، والمطالبة بالاستقلال عن كل العلاقة التي كانت تربطه بأكبر عضوٍ إلى أصغره، في هذه العائلة وأصدقائها في العالم، طلبا للاستقلالية والتّحرر الكامل لشخصه ولعائلته.
فالحرّية والتخلّص من السلطة العائلية هي غريزة مولودة ومغروسة في قلب كلِّ شاب، يحاول أن يحصل عليها، بكل ثمنٍ ووسيلة، عندما يبلغ سنّ النضوج. فمن يوم لآخر، يقف الفتى على رجليه، رافع الرأس أمام والديه، مُطالبا بالاستقلالية، والخروج من الجو العائلي، طلباً للحرّية، التي له الحق عليها، لكن مع علامة سؤال واستفهام: إلى أين ولماذا؟ هذا ومن الناحية الثانية، فإنَّ الأهل يعلمون، أنَّ لأولادهم أقداماً يجب أن يقفوا عليها. لذا فالأولاد المُدلّلين الاتّكاليّين، الّذين لا يشعرون بالحاجة للاستقلال، لا يُنمّون شخصيّة قويّة، وستنقصهم الخبرات الكثيرة للحياة، حينما يضطرّون بالتالي لترك البيت الأبوي.
نقول، الانفصال عن العائلة هو ليس بالهيّن، لكن يأتي وقت، لا بدَّ أن يتمّ، ذلك لما فيه من الخير، مثلا لمتابعة الدّراسة أو لاستلام وظيفة، بعيدة عن مسقط الرأس أو البيت الأبوي. لكن انفصال قصة اليوم هو من غير هذه الفصيلة أو العيار، إذ أسبابه وأهدافه، هي غير الأسباب والأهداف المذكورة.
هنا شاب متهوِّر، خطر على باله أن يغامر بحياته، ضاربا كلَّ الأهداف الضّرورية بعرض الحائط، ومتلهِّفاً فقط وراء الحرّية الخاصة، وبلا مسؤولية. لقد كان ذلك حدثا كبيرا في ذلك الزّمان، حيث كانت العائلة كلُّها تعيش تحت سقف واحد، وتأكل من نفس الصحن وتتقاسم نفس رغيف الخبز. كان هذا الخبر مثيراً، فاستأهل أن يكون مثلا من أمثال يسوع الشهيرة. لكن لا يجوز أن نفتكر أن المُمثِّل الرئيسي في هذه القصة هو الإبن، مثلما يُعطينا إياها الانطباع، حينما نسمع أو نقرأ هذا المثل، بل هو الأب، الّذي يحمل القلق على ابنه، ما دام لا يعرف إلى أين آلَ إليه مصيرُه.
هذه القصّة كانت دائما تحمل العنوان: قصّة الإبن الضّائع. أمّا الأرجح والأصح فهو عنونتُها: قصّة الأب الرحيم. هذا وما من قصّة في الأناجيل كلّها، نالت إعجاب الفنّانين والكُتّاب، بل ومخرجيي الأقلام، مثل هذه القصة. منهم من اهتمّ بإبراز دور الإبن الضائع، ومنهم دور الأب المسامح. كالأيقونات بوجهيها الاثنين. بهذه القصة، أراد يسوع أن يرينا، مدى اهتمام أبيه فينا، ما دمنا بعيدين عن البيت الأبوي، حتى ولو كنّا نحن، الذين ابتعدوا عنه، كآدم في الفردوس. لكن الله نزل إلى الفردوس يفتش عن آدم وينادي: آدم! أدم! أين أنت؟ ونعرف كيف انتهت هذه القصة بنهاية سعيدة، أي بتقديم ابنه كمخلّص. فالّذين أوجدوا أفلاما بنهاية سعيدة، هم ليسوا مُخرجو أفلام هوليوود، بل هو الله، المُخرج لكل الأفلام الدينية. فما حكى يسوع قصّة إلا وتنتهي بنهاية سعيدة، لأنها حقيقيّة. وبمثل هذه القصص، كان يريد أن يُلقّي درسا بقُساة القلوب، خاصة الكتبة ورؤساء الكهنة والفريسيّين.
نحن نعيش قي الغربة. لكن الله لا ينسانا، بل هو ينتظر عودتنا، بذراعين مفتوحتين، كأنَّ شيئا لم يحدث. فإن لا زلنا نتذكّر، هذا الفتى كان قطع كلَّ علاقته مع والده ومع أهل بيته، وهام على وجهه. وراح يربط علاقات من أسوأ ما في الحياة، علاقات بذخ وفسق وعار، وهي غير لائقة، إذا ما قورنت بنظافة العلاقة مع أهله. هذا الشاب قطع علاقته التامّة مع والده، أما والده فلم يقطعها مع ابنه، بل كثّفها في داخله، إذ بقي يفتكر فيه ليل نهار. إنه لم يعرف الهدوء، حتّى فجأة رأى ابنه من بعيد عائدا، فارغ اليدين، من بعد ما كان سافر بأموال طائلة. لكن من مشاهدته لمظهره من بعيد، قد اشتبه والده في ما حدث له.
وفعلا إن هذا الإبن، من بعد ما تنعّم بكل ما كان لديه من مال، أخذه معه عندما ترك البيت، بذّره كلَّه على الأفراح والملاذ الدنيوية، وبالتالي حتى يلاقي سيئا يأكله ليبقى على قيد الحياةـ اضطرّ لإشغال أوسخ وظيفة يتنازل إليها يهودي في ذلك الوقت، وهي رعاية الخنازير وتنظيفها وبالتالي أكل طعامها أي الخرنوب، فهذا أكبر عار. وإذا بنور فيه يُفهمه خطأه، إذ رأى نفسه، لا فارغ اليدين فقط بل والقلب أيضاً، لا صديق له ولا مُعين ولا مأوى. فلنتصوّر ما وصلت إليه نفسه من تعاسة! فكأنَّ بريقا أناره وذكّره بالرّفاهية التي كان غارقا فيها في طفولته وحتّى تركِه البيت الأبوي، ففاض قلبه بالحنين إلى هذا البيت، وعرف خطأه، بل ندِم على فعلتٍه: أقوم وامضي إلى أبي، فأقول له: يا أبتِ! إني خطئتُ إلى السّماء وإليك، ولست أهلا بعد، أن أُدعى لك ابنًا!. قال المثل: من أقرَّ بذنبه فكأنَّه ما أخطأ ألا يُذكِّرنا موقفه من جديد بموقف القديس أغسطين، الّذي أيضا كان بنفس الأسلوب، لم يترك طريقا إلا وسلكه طلبا للسعادة ، وبالتالي ما لقى إلا مُرّاً في الحياة، فعاد إلى نفسه ورجع إلى الله بقوله المشهور: لقد خلقتنا لك يا الله، ولن يستريح قلبُنا إلا فيك!
الوالد لم يبقّ واقفا في مكانه ينتظر وصول ابنه الضائع إليه، بل هو نفسه أسرع لمقابلته وضمِّه إلى صدره، ليُهدِّئ روعه، بل وليُعيد له حقوق البُنوّة التي فقدها بنفسه. بقدر ما كان قلب الأب مُتحرِّقا على ضياع ابنه، بقدر ما فاض حبّاً حين شاهده من جديد، حيّاً بين يديه. فلنتصوّر لحظة الفرح هذه. أما قالت رواية le cide الفرنسيية لكاتبها Pierre corneille
Le cœur a des raisons, que
la raison ne connait pas
أي: عند القلب أسباباً ولو أنَّ العقل لا يفهمها. فقلب الأب في هذه الساعة غلب على عقله. فما عاد الوقتُ وقتَ تأنيب، إذ ضميرُه قد أنّبه بما فيه الكفاية، ورجوعه نقدر أن نسمّيه إذلالا له. فقلب الأب لا ينزل إلى هذا المستوى، بل يريد أن يرفع من معنويات ابنه ويشجِّعه.
لذا فهو لا يريد أن يترك هذه المناسبة تمرُّ مرَّ الكرام، كما يقول المثل، بدون إشارة تُعبّر عن فرحه ومحبته لابنه، واندماجه من جديد في حياة العائلة، فلا يبقى يشعر بأنه عالَةٌ عليها، بل واحدٌ منها كالسابق. والده لم يسأله كيف وماذا عمل بحصة المال الكبيرة، الّتي كان قد اقتطعها له من ملك العائلة. كل هذا ولكثرة محبّته لابنه قد أغمض الوالد جفنه عنه. فالمهم أنه الآن حي يُرزق:. لذا فهو يأمر خدامه بإقامة حفلة ووليمة فرح كبيرة، يُذبح فيها العجل المُسمّن، الّذي كانت العادة ذبحُه، فقط للضيوف الكبار الأعزاء، فنأكل ونتنعّم، لانَّ ابني هذا، كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوُجِد. وليس بأقلَّ منها إرجاعُ الكرامة لابنه، بحيث يُلبسه حلّةً فاخرة، ويضع في يده خاتم الصّداقة، دلالة على التغيّر الدّاخلي، الّذي أظهره بالنّدم الصّادق لأبيه. نعم بهذه الحفلة، يعطيه أبوه كامل حقوقه المفقودة ويُعيده إلى حضن العائلة. فالإنسان بدون عائلة هو ليس إنسانا.
والان، من لا يرى نفسَه في هذه القصة؟ من لا يفهم أنّه هو المعني شخصيّاً، بمحبة هذا الأب، رغم الضياع وترك البيت الأبوي؟ الله لا يتركنا، بل يبقى باله مشغولا بنا، إلى أن نعود إليه تائبين. هذه قصه تلائم فعلا زمن الصّيام، ويهمُّ مجراها كلَّ واحد منّا، إذ توضِح لنا من هو هذا الأب، الّذي يتعامل مع ابنه بهذا الشكل. يسوع يحكي هذه القصة أمام الكهنة ورؤساء الشعب، الّذين انتقدوه مراراً وتكراراً لتسامحه وتهاونه مع الخطأة، حتى إنه يأكل معهم. أما هو فكان جوابه: من منكم بلا خطيئة فليرْم الحجر الأول. لقد أفحمهم بهذه الكلمة، بل أسكتهم، إذ طلب منهم: كونوا رحماء، كما أنَّ أباكم السّماوي رحيم.
هو يقول لهم، طبعا ولنا، إنَّ الله يتعامل معنا، مثلما تعامل هذا الوالد مع ابنه المُتمرِّد. بعكس تعليم التّوراة، الّتي تقول: إن تنجّس الإبن بأيّة طريقة، فلا يجوز للأهل الاختلاطُ به. بعكس تعليم يسوع، فهو لا يعرف النّجاسة، بل يلمس الأبرص ويشفيه، لان المرضى هم الّذين يحتاجون إلى طبيب. هو أسرع للقاء ابنه وضمِّه إلى حضنه، الذي كان مُتنجِّسا من ملامسته للخنازير، التي كان يعتني بها كأجير. المهم: هذا الفتى هو ابني ويبقى إبني، إذ الأب لا يقدر أن يتخلّى عن أُبُوَّتِه. هذا الأب هو الله، الذي قيل عنه في مكانٍ آخر: إني أريد رحمة لا ذبيحة. فكما تعامل الأب في هذه القصة مع ابنه الضائع، وفرح برجوعه إلى البيت الأبوي، هكذا الله، فهو يبقى فاتحاً يديه للخاطئ التائب، ويفرح لرجوعه. الله يفرح بتائب واحد يعود إليه خلال هذا الصوم. فهو ما عاد يذبح عجلا مُسمَّنا، بل قدّم ابنه عن كلِّ واحد منا: إذ بدمه قد شفينا. الحقّ أقول لكم، إنه يكون فرح عظيم في السّماء بخاطئ واحد يتوب، أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة (لو 7:15). الله يريد خلاصنا. وهذا هو وقت رحمته وخلاصه. فلنقم ونعود إليه.