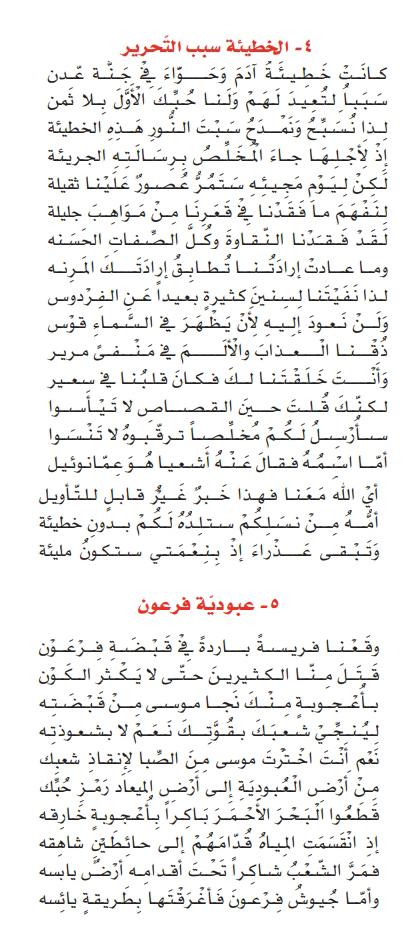موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
صوتُ منادٍ في البرّية: أعدّوا طريق الرب

الأب منويل بدر - الأردن
الأحد الثاني من المجيء، الإنجيل لوقا 3: 1-6
نتساءل: ما الفرق بين النّبي وبين المُؤرِّخ؟ النّبي هو شخص مُختار بعلامة سماويّة، ليخبر النّاس بأشياء مستقبلية، أوحاها الله له، هو نفسه ما كان يعرفها. وأمّا المُؤرِّخ، فهو صُحفي متخصّص، يكتب، إمّا التّاريخ الماضي، أو أنّه شاهَدَ بنفسه أحداثاً، يكتب عنها، ليؤكِّد حدوثها. إذن حقلُه، هو غير حقل النّبي.
لوقا، كاتب إنجيل هذه السنة، الذي فيه يصف مراحل حياة يسوع وأعمالَه، أصبح، بحكم دعوته، كمرافق أوّلا لبطرس، ثمّ لبولس، نبيّاً، لأنه كان يكتب باسم الله. إنّ تقاريره الوافية عن حُكّام مُلْكِ داؤد ونسله، لم تكن بالهيِّنَة، فهي ليست وصفاً تاريخيّاً فحسب، بل هي تتميمٌ وتحقيقٌ لبرنامج الخلاص، مِنْ قِبَلِه تعالى في هذا العالم. 4000 ألاف سنة انتظر العالم على تحقيق هذا الوعد، وبهذا التحقيق أصبح زماننا زمان الله، وقصّة حياتنا، قصّة حياة الله. وهذا ما نجده أيضا عند بعض الأنبياء،الّذين نسمع بعض النّصوص منهم في هذه الأيام، ومنهم خاصة أشعيا، أحدُ وجوه زمن المجيء هذا االبارزة. إذ يقول: إنَّ الله أرسله ليُبشّر بالخلاص للمساكين ومكسوريّي القلوب، والإفراج عن المساجين.
هذا ونقدر أن نقول، إنّ الله يستغلّ الإنسان، إن صحّ التّعبير، ودون علمه، ليحقّق خطّة الخلاص، التي افتكر فيها، وعرّف عليها قبل أن تحدث، بإرسال أنبيائه إلى البشر.
ففي إنجيل اليوم يذكر لوقا أسماءَ حُكّامٍ ووُلاةٍ رومانيّين، في محافظات عديدة، في الأرض التي كانت موعودةً لإسرائيل، ولكن لأن هذا الشّعب لم يبقَ مُحافظاً على وصايا إلهه، الّذي حرّره من عبوديّة فرعون، ثمَّ وقع في عبودية ثانية، هي عبودية نبوكدنصّر في بابيلون، إلى أن تاب، فأعاده يهواه من جديد إلى أرض الميعاد، في عاصمته أورشليم، فتمّت إعادة بناء الهيكل المُتردِّم من جديد. لكن ومن جديد، نسي الشعب وصايا وعهد يهوى الذي كان عَقَدَه معه على جبل سيناء، فأرسله في عبوديّة ثالثة، إلى صحراء بلاد ما بين النهرين. وهكذا صارت الصحراء منبر النّداء إلى التوبة، التي ذكرها لنا لوقا اليوم، والّتي تَحَمَّل يوحنّأ مسؤوليَّتَها.
أحد المجيء الثاني تحتلُّه دائماً شخصيّة يوحنّا، إذ أرسله الله ليبشّر بالنور.هو لم يكن النور بل جاء ليبشر بالنّور. لمّا ساد الظّلام في عالمنا، دخل يوحنا، أحدُ أكبرِ وجوه المجيء، بمَثَلِه الحيّ ومظهرِه المُقنع، يكرزُ بالنّور الجديد، الذي أتى إلى العالم، ليحثَّ النّاس كافّةً على التوبة والإيمان به. جاءت الجماهير تسأله: ماذا عليهم أن يفعلوه ليأتي المخلّص؟ لقد كان عنده كلمة بل جوابا لكلِّ سائل، وكان جوابه واضحاً للجميع: توبوا. غيِّروا مجرى حياتِكم، واسلكوا الطريق الصحيح! الطُرُق كثيرة لكن واحدة منها فقط هي الصحيحة، وتقود إلى الهدف. طريقُ الشّعب من عبودية فرعون حتّى العبورِ إلى الأرض الموعودة، ما كانت طريقا مستقيمة، بل وعرةً، ومليئَةً بالمخاطر، خاصة بالحروب ضدّهم، من الشعوب التي كانوا مرّوا حواليها، ووقفتْ لهم بالمرصاد، فتألم الشّعب كثيرا. لكنها بالتالي قادته إلى هدفه.
فيوحنا يوصي السائلين أن يسلكوا الطريق الصحيح، وهو: توبوا واعتمدوا، بعكس توقّعاتِهم. هم كانوا بانتظار مُحرِّرٍ سياسي بجيوش، لطرد المستعمِر، وتأسيس دولة يهودية في أورشليم، يتبعُها الإستقرارُ الدّائم بعد مئآت السنين من العبوديات الطويلة المختلفة، تماماً كما تنتظر شعوبُنا العربية بعد كل انقلاب وتغيير حكومة. هل نسينا توقّعاتِ البشر وآمالَهم بعد التغييرات الحكومية التي أنعشتها ثورة الرّبيع العربي عام 2010؟.الجماهيرفي ذلك الزّمان كانت كلُّها تتأمّل وتنتظر مُحرِّراً عسكريّاً سياسيّاً. إلاّ أنّ يوحنّا قد صحّح هذه الإنتظارات والآمال المغلوطة. إذ إنَّ هدفَ تحرير الله للبشر، هو ليس تحريراً سياسيّا. هو مُلْكٌ يَعدُ غيرَ ما يعدُه الملكوت الأرضي. فالبشر لا ينتظرون شيئاً بل شخصاً، وهذا الشخص هو ليس أي شخص، كنبيٍّ مثلا، بل هو ابن الله، الّذي بدخوله في التاريخ، سيبدأُ عهدا وتاريخاً جديدا، ولكي يحرِّر البشر، فقد صار واحدا منهم، مشابهاً لهم في كلِّ شيء ما عدا الخطيئة، حتى يقدر أن يُنجّيهِم من الخطيئة. إذن هو ما أتى لتحريرٍ سياسي، وإنّما للتحرير من سلطة الشّر، المسيطرة على هذا العالم منذ خطيئة الفردوس، التي جرّدتنا من كل ما هو إلهيٌّ وصالِحٌ فينا, وبالتّالي جعلَتْ من الجنَّةِ فردوساً مفقودا. فمهمَّةُ يوحنّا كانت، أن يُوجِّه أنظارهم إلى هذا المُخلِّص، الّذي سيرجِعُهُم إلى هذا الفردوس، لكنهم لا يعرفوه، لأنَّ عيونَهم لا تزال مُغطّاةً بالخطيئة. هذا المخلّص، هو صار بينهم وهم لا يعرفونه: :إصنعوا ثمارا تليق بالتوبة" (لو 7:3) فالديانة لا تعرف التّردّد: إما التوبة فالخلاص، وإمّا لا توبة، فلا خلاص، وإلاّ فسيرسلهم غضب الله، إلى النار المُحرِقَة، كالشّجرة الّتي لا تُثمر، فتُلقى في النّار. فهو وإن كان طفلا في المهد، فهو في الوقت ذاته حاكم العالم. أمّا فلكي يعرفوه، فذلك مُرتبط بشّرط ٍمُهِمّ، ألا وهو التوبة، فيتم اسقبالُه بقلوب نظيفة. يمكن تشبيه التوبة بالبوصلة المغنطسية وأهمّيتِها، فهي تُشير دائما إلى القطب االشمالي فيعرف المسافر، خاصّة البحّارة والقباطنة توجيه سُفُنهم إلى الشّواطئ المقصودة. هكذا التوبة، فهي توصلنا إلى ميناء خلاصنا، إلى التّقرّب من الله. نحن، لأننا من الله، نأتي وفينا حتّى قبل أن نعي، شعورٌ دينيٌّ عميق، لا يمكن قتلُه. من يفصلنا عن محبة الله، يتساءل بولس. لا تجارب ولا اضطهادات ولا سجن ولا قتل، فنحن خلقُه، مرتبطون به كما الظلُّ مرتبط بجسمنا، لا يمكن لا فصلُه ولا مفارقتُه. فأينما عشنا وحيثما وُجِدنا، تشتاق نفسُنا دائما له. لقد خلقتنا لك يا رب ولا يستريح قلبنا إلاّ فيك. والمجيء يزيد من اشتياقنا للّقاء به.
كلُّ حياة يوحنا كانت في خدمة يسوع، والتعريف عليه بشجاعة، كما فعل مع هيرودس حبث انتقده على حياته الزّوجية الفاسقة. هذا وكان معروفاً، أنَّ من ينتقد الحاكم، كان أيضا يعرف أنّ قصاصَه غالباً ما كان الموت، لكن يوحنا ما اهتزَّ له ساكن ولا قلب، حين وقف أمام هيرودوس ووبّخه قائلا: لا يحقُّ لك أن تتزوّج امرأةَ أخيك! فتقديرا للدّور الكبير الذي قام به، لتحضير الناس، لاستقبال المخلّص المُنتظر، ما مدح يسوع نبيّا، مثل ما مدح يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرّية لتنظروا؟ أقصبةً تُحرِّكها الرّيح؟ لكن ماذا أنتم خرجتم لتنظروا؟ أإنساناً لابساً ثياباً ناعمة؟ هوذا الّذين يلبسون الثّياب النّاعمة، هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرحتم تنظرون؟ أنبيّاً؟ نعم أقولُ لكم، وأفضلَ من نبي. إذ الحقَّ أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنّا المعمدان" (متى 11.7). هو الملاك المُرسَل ليهيئ الطّريق قُدّامك (متى 10:11).
فيوحنا هو مثالُ شخصيّاتِ المجيء البارزة لكل مسيحي. إذ الله دعا كل واحد، ليتمثّل بيوحنا في التبشير، ليفتح القلوبَ للمخلِّص. كلُّ مسيحي هو مبشِّرٌ، حيث هو يعيش. فلا يجوز لأيِّ مسيحي أن يكون لامبالياً بما يخص التبشير! لكن أصعب مهمّةٍ، سواءٌ للمبشر أو للمسيحي أو للكاهن أو لمعلّم الدّين، هي أن يوصل رسالة دينية اليوم. بالمقابل لا يجوز لأيِّ عائق أن يمنعنا عن التبشير. أما قال بولس: الويل لي إن لم أُبشّر! والمجيء هو من أبرز الأوقات للتبشير بمجيء المخلّص. لقد حان الوقت لننهض من النوم، يقول بولس.
وما دور الكنيسة بأقلِّ أهميّةً من دور يوحنا، أي أن تسعى لتبديد الظّلام السّائد في هذا العالم، وتنشُرَ فيه هذا النّور، ليعود إلى الإيمان فيخلص. فالإيمان كما والخلاص هما نِعَم إلهيّة، يُقدّمُهما الله للجميع. فنصيحة يوحنا هي: أعدُّوا طريق الرّب واجعلوا سبله قويمة (لو 3:3). هي نصيحة ليس فقط لمستمعيه في ذلك الزّمان، بل ولنا نحن أيضا أبناءُ اليوم. هذا ويمكن أننا افتكرنا أنَّ التّحضيراتِ الخارجية، من هدايا، ولو غالية الثمن، كما والتفكيرُ في المأكل والمشرب ليوم العيد، مع العائلة وغيرِها، هي الّتي تساعدُنا على الفرح بالعيد. لكن هذا أكبرُ خطأ، بل أكبرُ عائق، لنشعر بفرح العيد، إذ الإهتمامُ بتحضير المادّيات، ما هو بديل لتحضير النفس والقلب، والتّعرّف على صاحب العيد. أنتم لا تعرفونه، لأنه سيولد في مذود. نعم التّعرّف على هذا الطفل، المضطجع في مذود هو مهمّ بل أهمُّ من كلِّ التحضيراتُ لحياتنا. هو الّذي يجعلُنا نشعرُ بالخلاص، الذي يأتي فقط من فوق، من الله! إذ الإنسان لا يستطيع خلاص نفسه بنفسه. فلو استطاع، لكانت كلُّ قصّة الله معنا خرافة بخرافة. وهذا مستحيل، حتّى الّتفكيرُ فيه. لذا فالإنسان هو بحاجةٍ لمجيء الله لخلاصِه. الإنسان خاطئ ويحتاج مجيء الله ليخلِّصَه من خطيئته. من منكم بلا خطيئة فليرمها بأوّل حجر! حياة، بدون تدخّل الله فيها، غير موجودة. فلولا تدخّل الله في خلاص شعبه من العبودية الفرعونية، لما كان هذا حدث. وخلاص جميع الشّعوب من عبودية الخطيئة، ما له علاج، سوى تدخّلِ الله وإرسالِ إبنه إلى الموت عن الجميع! فعملُ الله في هذا العالم صار، بموت ابنه، محسوساً ملموساً. وهذا ما عنته الرِّسالة المأخوذة من النّبي باروك(وكلُّه أوصاف لحالة الشعب بعد انتهاء المنفى)، حيث يُخبرُ أورشليمَ بما عمله الله لها: "إخلعي يا أورشليم حلّة النَّوْح والمذلّة، والبسي بهاء المجد، من عند الله. تسربلي ثوب البرِّ، الّذي من الله، فإنّ الله يُظهر سناكِ، لكلِّ ما تحت السّماء". فهذا يُبرهن لنا، كم نحن مُهمّون في نظر الله. فلا توجد حياة بشرية ميؤوسٌ[ منها أو لا طائلَ من ورائِها. هو الله فقط الذي يقدر أن يساوي كلَّ المطبّات في حياتنا مستقيمة. فبدون عملِ الله هذا في حياتنا عن طريق ابنه، لكُنّا ضِعنا، وإلى الأبد، وما كنّا وجدنا طريقَنا إلى الجنّة من جديد. وهذا ما أوصله لنا الأنبياء، وكان يوحنا خاتِمَتَهم، بكلماته المتكرِّرة: توبوا وآمنوا بالإنجيل.
اليوم هو مبدئيّاٍ حسب التّقويم الليتورجي، الأحد الثاني من المجيء، ولكن حسب المعروضات والمبيعات باسم العيد، سواءٌ على الشّارع أو في الأماكن التجارية، أو حسب الموسيقى الصاخبة، التي نسمعها في كل مكان، خاصة ترانيم العيد، التي ابتدآت حتى قبل ابتداء المجيء بأسابيع، كأننا صرنا من زمان في احتفالات عيد الميلاد. إذ بالنسبة للأسواق، فلا مجال ولا فائدة للإنتظار، وخاصّة للتحضير الرّوحي والصلاة، فهي لا تُعطي للأعياد حقّها. فلا أدري ماذا بقى من أفراح نتذوقها يوم عيد الميلاد بالذات؟ وهذا خطأ، إذ البيع والشّراء، لا يجلبان ذاك الفرح، الّذي نكتشفه في أعين الأطفال البريئة، إذ لعيد الميلاد سِحْرُه الخاص، على العقول والقلوب. ولا معنى له، إذا احتفلنا به قبل حدوثِة، كمن يحتفل بعيد ميلاده قبل الموعد بأسابيع. أعدّوا طريق الرّب واجعلوا سبله قويمة. آمين