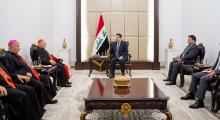موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

يَصل وديع (67 عاماً) إلى باحة الكنيسة، والعرق يتصبَّب من تجاعيد وجهه، يبدو منهمكاً وكأنّ الساحة لا تتّسع له، بيدِه اليمنى طابةٌ وعبوة مياه، وباليسرى يمسِك بابنتِه سهام (27 عاماً) المعوّقة. يتلفّت يميناً وشمالاً، يَبحث بنظراته عن «شوَيِّة فَي» لها، فيُجلِسها على الدرج المحاذي للكنيسة، فيما لا يأبه لنفسه، فيستريح على حجر باطون، مكرّراً على مسامعها: «المهمّ يا بابا تضلّك قدّام عيوني»، ثمّ يبدأ بكلّ حنان يدحرج لها الطابة، ويعلّمها كيف تردّها له. رغم تعذّرِ سماعها كلمات والدها، كانت البسمة لا تفارق وجهَها، فيما عينا والدها تشعّان أملاً، أمّا المارّة فكانوا يتهامسون «أوف شو صليبو كبير».
تَشهد حجارة كنيسة السيّدة في إحدى القرى اللبنانية الشمالية، على أنّ وديع لم يخلَّ يوماً بوعده مع ابنته، فلا تعليقات الناس هدّت عزيمتَه ولا عمله من الفجر إلى النجر أطفَأ شعلة أمله. فيتحدّث لـ«الجمهورية» بدموعه عن بدرٍ كاد يفقِده في ليلة ظلماء، قائلاً: «سهام شغلي الشاغل، من دونها أضيع، فهي ولدَت على نحو طبيعي، لكنّ خطأً طبّياً منع عنها الأوكسيجين وخسرَت على أثره جزءاً من قدرتها الحركية، وبعد خضوعها لعملية، تعرّضَت لخطأ طبّي آخَر، وبدأت كلّما تكبر يسوء وضعها الصحّي».
لا ينكِر وديع أنّ تعليقات المارّة تَجرحه وتذكّره بمصابه الأليم، ولكن مع الوقت زاد قناعةً بأنّ المؤمن لا يَحمل أكثرَ مِن طاقته، لذا يَرفض رفضاً باتاً مقولة «صليبو كبير»، مؤكّداً: «الدِني بألف خير، أمنيتي فقط أن تبقى لي القدرة على الاعتناء بابنتي والتمويه عنها»، ثمّ ركضَ يضمّها إلى قلبه مبتسماً، فيما سهام تنظر إليه بكلّ أمان، تسَرّع وتيرةَ حركة رموشِها وكأنّها تعانقه بعيونها.
يَصعب معرفة المشاعر التي تراود وديع وهو يضع رأسَه على وسادته، ويتعذّر تقدير ما يَجول في بال ابنتِه وهي تتأمّل صبايا الضيعة يتهرّبنَ مِن «تلطيشات» الشباب، فيما تجلس هي على الدرج. إلّا أنّ كليهما أدركا تحويل أوجاعهما فرحاً بإصرارهما على حبّ الحياة، فشَكَّلا عبرةً لأهالي الضيعة. حالُهما كحال تلك الأرملة التي خسرَت ابنتَها بعد عامين على وفاة زوجها بذبحةٍ قلبية، فاجعةٌ أسكرَت القريبين والبعيدين حزناً، على اعتبار «أنّها معتّرة صليبا كبير، شِي بكفِّر»، أمّا تلك الأرملة المتّشِحة بالسواد فآثرَت الصمت، وبعد أشهر طويلة لم تغادر فيها منزلها، باتت تَخرج إلى القداس عند السادسة مساءً ولا تتقاعس عن أيّ نشاط في الرعية.
ماذا يعني «الصليب»؟
المرَض، الفراق، الموت، الإعاقة وغيرُها من المحطات التي يواجهها المرء في حياته، يقرنها بكلمة الصليب، فاعتَدنا القول: «كِل واحد صليبو عَ قدّو».
في مناسبة عيد ارتفاع الصليب، يوضح الأب رِفعَت بدر، مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن، أنّ لعيد الصليب أكثرَ مِن محطة في حياة المؤمنين: «بالإضافة إلى يوم الجمعة العظيمة التي تُحيَى فيها مراسم آلام السيّد المسيح على الصليب، هناك عيدان في بحر السنة: الأوّل ارتفاع الصليب المقدّس، ويُحتفَل به في 14 أيلول من كلّ عام. أمّا العيد الثاني فهو «وجدان» الصليب المقدّس، أي العثور عليه على يد القدّيسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين. قد يَخلط المؤمنون بين العيدين، ليس هناك مشكلة، المهم إكرام الصليب».
ويوضح بدر: «بعد صلبِ المسيح، ردَم اليهود القبر ودفَنوا الصليب المقدّس وصليبَي اللصَّين الآخرَين اللذين كانا معه، لإخفاء معالم يسوع، نظراً إلى المعجزات التي كانت تحصل في جوار القبر. فاختفى الصليب لنحو أكثر من قرنَين». ويضيف: «في مطلعِ القرن الرابع الميلادي أراد قسطنطين أخذَ روما، وأن يصبح إمبراطور الغرب. عام 312 شنَّ معركةً ضدّ عدوّه ماكسينتيوس على مشارف المدينة قرب نهر التايبر، وعشيّة المعركة ظهرَ الصليب في السماء محاطاً بعبارة «بهذه العلامة تنتصر».
كانت والدة قسطنطين الملكة هيلانة مسيحية، لذا كان لديه تعاطفٌ تجاه المسيحية، فجعلَ رايةَ الصليب تخفق، وأصدرَ مرسوم ميلانو عام 313، وسَمح بالمجاهرة بالديانة المسيحية، وخاض المعركة وانتصَر. وبعدما بات إمبراطوراً هدَم معابد الأصنام وشيَّد الكنائس. ونحو عام 327 قصَدت هيلانة الأراضي المقدّسة قرب جبل الجلجلة للبحث عن خشبة الصليب المقدّس، بعد الحفرِ والتنقيب عثرَت على ثلاثة صلبان».
يتوقّف بدر عند حادثة مؤثّرة جداً ساهمت في تحديد صليب المسيح، قائلاً: «إقترح البطريرك مكاريوس أن يختبروا فعاليّة الصليب، فوضَعوا الصليب الأوّل على امرأة تُنازع من مرض طويل، فلم يَحدث شيء، وكذلك الثاني، لكن عندما وضَعوا الصليب الثالث قامت المحتضرة، وبذلك تعرّفوا إلى الصليب الحقيقي».
نار... ورمّان
تُرافق ليلةَ عيد الصليب، بالإضافة إلى الصلوات الخاصة والقراءات، إحتفالاتٌ شعبية وعادات رمزية، منها إشعالُ النار وتناوُل حبّات الرمّان. فيوضح بدر: «يعود إضرامُ النار إلى عيد وجدان الصليب المحتفَل به في 7 أيار من كلّ عام، حين جاءت القدّيسة هيلانة إلى القدس، بغية بناء كنيسة القيامة، ويخصّ الشرقيون هذا اليوم بإكرام خارق، بعد ظهور علامة الصليب الكريم في السماء، في مدينة القدس، في 7 أيار 351، إذ امتدّت أشعّة الصليب من الجلجلة إلى جبل الزيتون.
وهناك تقاليد تقول إنّ القدّيسة هيلانة أرادت إخبارَ ابنِها الإمبراطور في روما بأنّها وجَدت الصليب، فوضَعت أشخاصاً على رؤوس الجبال لكي يخبِروا بعضهم بعضاً بالحدث السعيد، عن طريق إشعال النار فوق رؤوس الجبال». ويتابع: «اليوم تشعِل الجماهير النار بطرُق احتفالية، ويلتفّون حولها فرحين بالمسيح المخلّص الذي «أحرق» خطايانا بموته على الخشبة. أمّا تناوُل الرمّان، فعائد إلى أنّ الحبّة الواحدة ترمز إلى الكنيسة: فالتاج هو ملك المسيح، وحبّات الرمان تشكّل، على تعدّديتها، حبّةَ رمانٍ واحدة، وهي أنّ السيّد المسيح أرادنا أن نكون واحداً على كثرتِنا».
من العار... إلى المفخرة
يَشرح بدر المعنى الجديد الذي اكتسبَه الصليب بعد صلبِ المسيح، موته وقيامته، قائلاً: «كان الصليب قبل المسيح أداةَ عقابٍ، يُستخدَم مشنقةً أو «كرسيَّ إعدام». أداة استخدَمها الرومان لتعذيب المجرمين أو الخارجين عن القانون أو المعارضين لسلطتهم. لكن بعد المسيح تغيَّر الأمر جذرياً.
لأنّه لم يُصلب لجرم اقترَفه، بل لأنه أراد إصلاح البشرية، بتصالحها مع الله تعالى». ويضيف: «اليهود نظروا إليه على أنّه لا يلبّي طموحاتهم الدنيوية، والرومان اعتبروه سبب خلاف قد يؤدي إلى ثورة ضد «حكمهم» ونفوذهم. التقت الإرادتان البشريتان الطامعتان في حكم الأرض: اليهودية والرومانية، فحكم على «البار» بأنّه شرّير».
أمّا بالنسبة إلى المسيحيين؟ فيُجيب بدر: «مات السيّد المسيح على الصليب «كفارة عن الخطايا». لم يشَأ أن تبقى البشرية هالكةً في غياهب السجون وظلام الخطيئة، أراد أن يحرّرَنا، فمات لكي يقوم بعد ثلاثة أيام وينقِذ البشرية. ولذلك أصبحنا نقول: مات لنموتَ عن الخطيئة، ومن ثمّ نهض لكي يُنهض البشرية المنكسرة».
في هذا السياق، يَعتبر بدر أنّ «الصليب فخرُ المسيحي»، مسترجعاً كلامَ القدّيس بولس: «معاذ الله أن أفتخر إلّا بصليب السيّد المسيح» (غلاطية 6: 14). ولكنّ هذا الفخر ليس شاعرياً وسلبياً، بل هو استعداد للمسيحي كذلك أن يحمل صليبَه كلّ يوم ويتبع السيّد المسيح».
ويروي: «قالت لي إحدى السيّدات المسيحيات، المهجّرة من الموصل: طُرِدنا من بيوتنا، فحَملنا صليبنا وجئنا إلى الأردن. واليوم تستعدّ هذه العائلة لتحملَ صليبَها مجدّداً وتهاجر إلى أوستراليا. إنّ كلّ من يتحمّل الألم، خصوصاً في سبيل إيمانه، وبسببِ إيمانه، هو حاملٌ للصليب، ويستمدّ قوَّته من المصلوب نفسِه».
خمسة أصابع... وثلاثة
قبلَ رسمِ إشارة الصليب، ومع نشأة الاضطهاد، لم تكن الرموز علنيةً، بل كان يُرمَز للمسيحيين بإشارة السمكة (حيث تشير الحروف اليونانية لها بجملة: المسيح الرب مخلّص البشرية). ثمّ عندما أصدِر مرسوم ميلانو عام 313، وتمَّ الاعتراف بالمسيحية كديانةٍ رسمية، وأقِرّت الحرّية الدينية، بدأ أتباع السيّد المسيح يَرسمون إشارةَ الصليب.
في هذا السياق يَلفت بدر إلى رسم الإشارة وفقَ طريقتين، قائلاً: «الرسم الأوّل شرقي ويُرسَم بثلاثة أصابع، رمز الثالوث الأقدس، والإصبعان الباقيان رمز لطبيعتَي المسيح الإلهية والإنسانية. أمّا راحة اليد فهي الأمّ البتول مريم. الرأس هو السماء، ونزول الابن هو التجسّد، والجهة اليمنى: جلس عن يمين الآب، واليسرى هي شمول الكون كلّه. أمّا التقليد الغربي فيرسم بخمسة أصابع، رمزاً إلى وصول البشارة المسيحية إلى القارّات الخمس في العالم». ويشير إلى أنّ «سرّ المعمودية (الدخول في عائلة الكنيسة) يبدأ برسم إشارة الصليب على جبين الطفل، وهو مع والديه، على بوّابة الكنسية، إنّها تمثّل دخوله إلى عائلة المحبّة».
«شركة وشهادة»
في هذه المناسبة، يتذكّر مسيحيّو الشرق عموماً، واللبنانيون تحديداً، محطة تاريخية غالية على قلوبهم. ففي 14 أيلول 2012 زارَ البابا بنديكتوس السادس عشر لبنان، ووقّعَ في كنيسة القدّيس بولس في حريصا الإرشادَ الرسولي الخاص بالمسيحيين في الشرق، وعنوانه «شركة وشهادة».
أمّا عن دلالات التوقيت في يومنا هذا 14 أيلول، فيقول بدر: «أوّلاً لكي يشجّع مسيحيّي الشرق في كلّ دقيقة على حملِ صلبانِهم. وثانياً لكي يؤثّروا في مجتمعاتهم على مزيد من الحرّية الدينية. صحيح أنّ حرّية العبادة موجودة، لكن بنِسَب متفاوتة، فنحن نحتاج إلى مزيد من الحرّية الدينية في مجتمعاتنا العربية. وهذا ما أكّده الإرشاد الموقّع في مِثل هذا اليوم».
في الختام، لا شكّ في أنّ مجتمعاتنا مثقَلة بالأوجاع، تعتصر الخيبةُ قلوبَ شِيبها، وأملُ شبابها يترنّح، أمّا الأمَّهات فثُلثهنّ متّشِحات بالأسود، ولا يَرقصنَ إلّا في الجنازات حزناً... ولكن وسط هذا الليل الدامس يطلّ عيد الصليب علينا ليزيدَنا شجاعةً وإصراراً على التمسّك بالحياة بحلوِها ومرّها، فما بَعد الصليب وأوجاعِه وموته... قيامة!