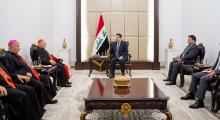موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

صدر حديثًا كتاب جديد للأب الدكتور ريمون جرجس الفرنسسكاني، المتخصص في القانون الكنسي، وفيه يقدّم دراسة تحليلية قانونية حول تجديد أصول المحاكمات الكنسية في قضايا إعلان بطلان الزواج وفقًا للبراءة الرسولية "الرب يسوع القاضي العطوف"، و"يسوع العطوف الرحوم".
والمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، وموقع أبونا الإلكتروني، فيما يهنئ الأخ والصديق الأب جرجس على هذا الانجاز الجديد الذي يضاف إلى سلسلة مؤلفاته حول القانون الكنسي، فإنه يسرّه أن ينشر المقدّمة التي كتبها الأب جرجس للكتاب الحالي:
إنَّ مبدأ "الإصلاح في الكنيسة" Ecclesia semper per reformanda أساسيّ وجوهر عمل الكنيسة عبر تاريخها. فهو يظهر طبيعة الكنيسة على أنَّها "كنيسة سنيّة لا دنس فيها ولا تغضُّن ولا ما أشبه ذلك، بل مقدّسة بلا عيب" (أفسس 5، 27)؛ فهي ما تزال تتجّه نحو تحقيق هدفها بأن تكون كنيسة نقية ومقدّسة بجملتها؛ فقد عرفت أوقاتا من القوّة والضعف في مسارها التجديدي، لمواجهة تحديات التي طرحها التاريخ. فتاريخ الكنيسة هو تاريخ إصلاحي.
ولا شك من أنَّ المسار الإصلاحي استمر حتى في مرحلة المجمع الفاتيكاني الثاني وما بعده، هناك دساتير وقرارات غيّرت وجه الكنيسة، فكان المجمع إصلاحيّ على نطاق واسع. يؤكد المجمع في الدستور العقائدي حول الكنيسة "نور الأمم" أنَّ الكنيسة الأرضية لم تتوقّف أبداً من تجديد ذاتها بفعل الروح القدس (رقم 9)، ويعبّر في القرار حول الحركة المسكونية عن ضرورة الإصلاح المستمر: "الكنيسة ما استمرّت في مسيرتها، يدعوها المسيح الاله إلى هذا الإصلاح المستمر لأنها على الدوام بحاجة إليه من حيث هي مؤسَّسة بشرية وأرضية. فلئن حدث إذن أنَّ الأحوال قد حالت أحياناً دون القيام بمثل هذه الإصلاحات في نطاق الأخلاق والنظام الكنسيّ، بل حتى في طريقة التعبير عن العقيدة-التي يجب تمييزها عن وديعة الإيمان-، فتجب العودة إليها في الوقت المناسب بما يلزم من الجد والاستقامة" (رقم 6).
يقتضي القبول المستمر للرسالة الموحاة مطلباً أساسيّاً من الأمانة في الإيمان والمحافظة على الكلمة الإلهيَّة. وسميت في عالم الفكر القانونيّ: الوديعة. وتقع مهمّة المحافظة على الكلمة ضمن مسؤوليَّة شعب الله كلّها. فلا يمكن إعفاء أيّ مؤمن أو جماعة مؤمنين من هذه المسؤوليَّة، ضمن مجالها في الحياة وإمكانياتها. فهذا يعتبر حقّ المؤمن في المحافظة على الكلمة، أي أن لا يكون مهدداً لتمسكه بإيمانه. فهناك تصرَّفات من قبل المعمّدين تضرّ أو تهدد الإيمان، وتشكّل ظلماً حقيقيّاً، لأنها تهاجم حقّه في العيش ضمن "بيئة كنسيّة سليمة". فالأمانة الشخصيّة للكلمة تتطلب إتمام جميع الواجبات المسيحيَّة، ولا سيما في بعديها التنشئة الدائمة وانسجام الحياة مع الإيمان. بالتأكيد قد يتعرّض المؤمن لتهديدات داخليّة وخارجيّة ضدّ إيمانه، وليس بالضرورة أنَّ تشكّل ظلماً، إلاّ إذا كانت ضدّ الحقّ الطبيعي للحريَّة الدينية، هذا في حال كانت التهديدات خارجيّة؛ أمّا إذا كانت من داخل الكنيسة، فإنَّها تعتبر انتهاكاً للواجب القانونيّ في المحافظة على الإيمان.
مبدأ الأمانة أولا إلى الكتاب المقدس والتقليد المقدس، اللذين "يرتبطان ببعضهما ويشتركان فيما بينهما بصورةٍ وثيقة، و"يُكوِّنانِ وديعةً واحدةً مُقدَّسة لكلامِ الله أوكِلَت إلى الكنيسة"، والتي تلهم الكنيسة جمعاء، تغني التقليد الكنسيّ، وفيها تعمل السلطة التعليمية، كمترجم رسميّ "لكلمة الله المكتوبة والمنقولة": "هذا التقليد الذي استلمناه مِن الرسل يتقدَّم في الكنيسة بمعونةِ الروح القدس. فإدراكُ الأمورِ والأقوال المنقولة يَنمو إمَّا بتأمُّلِ المؤمنين الذين يُردِّدونها في قلوبهم ودراستهم (لو 2 / 19 و51)، وإمّا بتبصُّرِهِم الباطنيّ في الأمور الروحية التي يختبرون، وإما بكرازةِ أولئك الذين تسلَّموا، مع الخلافةِ الأسقفية، الموهبةَ الثابتةَ لتعليمِ الحقيقة. أي أنَّ الكنيسةَ تتوق باستمرار، على مَرِّ الأجيال، إلى كمالِ الحقيقةِ الإلهيَّةِ، إلى أن تَتمَّ فيها أقوال الله". "على أنَّ هذه السُلطة ليست فوق كلام الله ولكنَّها تخدمه، إذ إنها لا تُعلِّمُ إلا ما إستلمته، بحيث أنَّها بتكليفٍ من الله وبمعونةِ الروح القدس تُصغي إليه بتقوى وتحفظه بقداسةٍ وتعرضه بأمانةٍ. ومن وديعة الإيمان الواحدةِ هذه تنهلُ كل ما تقدمُّهُ من حقائقَ يجبُ الإيمان بها كموحاةٍ من الله. بناءً عليه يتَّضِحُ أنَّ التقليد المقدس والكتاب المقدس وسُلطة الكنيسة التعليمية، بتدبيرٍ إلهيٍّ كُلّيَّ الحكمة، ترتبطُ ببعضها وتشتركُ فيما بينها، إلى حدِّ أنَّ لا قيامَ للواحد منها دون الآخرين، وإنها كلّها مجتمعة، وبحسب طريقةِ كلٍّ منها وبتأثيرِ الروحِ الواحدِ، تُساهم بصورةٍ فعّالةٍ في خلاصِ النفوس".
ومن هنا ينشىء واجب القاضي بأن يكون أميناً للشَّرع الإلهي، الطبيعي، الايجابي، الكنسي والقضائي، والذي يرتكز على خضوعه للأنظمة التشريعية الكنسيَّة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقوانين الزواج، فلا مكان للبحث الحُر عن القانون من خلال تفاسير نفسيَّة واجتماعيَّة محضّة، بدون الأخذ بعين الاعتبار بالعناصر الجوهريَّة القانونية. ولكي يُفسر القاضي الشرع، يجب اللجوء إلى نيّة المشرّع mens legislatoris وإرادته voluntas Legislatoris، أي إلى روح وقلب النظام الذي ينبض تحت سطور الكلمات المنظورة للنَصَّ التشريعي. يقول البابا يوحنّا بولس الثاني على وجه صراحة في المرسوم الرَّسولي Sacrae disciplinae leges : " أنَّ الأداة، أي المجموعة القوانين، تتطابق بالكامل مع طبيعة كنيسَة، بشكل خاص كما قدَّمه التعليم المجْمع الفاتيكاني الثاني بالعموم، وخصوصاً من تعليمه حول مفهوم الكنسي. بل، هذه المجموعة القوانين الجديدة يُمكن أن تُفهم كجهد كبير في ترجمة هذه التعاليم نفسها باللغة القانونيَّة، أي مفهوم كنسيّة المجمعي. إذا كان من غير ممكن ترجمة صورة كنيسة بشكل كامل بألفاظ قانونيَّة، مع ذلك على المجموعة القانونيّة أن تتوجّه دائماً لهذه الصورة، كنموذج أول، حيث ان يُعبر عن نفسه. ينجم عن هذا بعض المعايير الأساسيّة، التي تسوس الشرع الكنسي الجديد. يمكن أن نؤكّد بنشوب الطابع التكميلي الذي يُقدَّمه الشرع في علاقته مع التعليم المجمع الفاتيكاني الثاني، وبشكل خاص بالدّستورين العقائدين "نور الأمم" و"فرح ورجاء".
التقليد، بالنسبة للبابا فرانسيس له قيمة ليس بوصفه عنصر تحجير مؤسسات وشكل الكنيسة التي نريدها، لكن قد يساعد في حد ذاته، على تعزيز عنصر ديناميكي والمرن وقابل للتكيف في النظام، لجعله أكثر ملاءمة مع المجتمع الكنسي. يُصّر البابا فرانسيس، في الواقع، على الله -الرحمة كأساس "للإنسانية الجديدة"، مبدأ الذي على الكنيسة نفسها أن تبدأ منه. في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الكنسيَّة فلورنسا بدأ مبيّناً كيف قبة الكاتدرائية تمثّل الدينونة العامّة، ويسوع في المركز وفي الجزء العلوي من الجص نقش "ecce homo". وهذا قاد البابا أن يذكرنا أنَّ يسوع لا يأخذ "رموز الدينونة، بل يرفع يده اليمنى مبيّناً علامات العاطفة، لأنه" بذل نفسه فدية لأجل الجميع" (1 تيم 2: 6). "إن الله لم يرسل الابن إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم" (يوحنا 3: 17). ولا يزال البابا فرنسيس يشير إلى العلاقة بين العدالة والرحمة وأي من المصطلحين ينبغي أن يعطى له الأولوية: "الرحمة لا يتعارض مع العدالة ولكن تعبّر عن سلوك الله نحو الخطأة، مقدّماً لهم فرصة أخرى للتوبة، الاهتداء والايمان... فإذا توقّف الله عند العدالة فيتوقّف أن يكون الله، سيكون مثل كل البشر الذين ينادون باحترام الشرع. فالعدالة وحدها غير كافية وتعلم التجربة أن مناشدتها فقط يهدد بتدميرها. لهذا الله لا يتجاوز العدالة بالرحمة والمغفرة. وهذا لا يعني تخفيض قيمة العدالة أو جعلها سطحية، بل على العكس من ذلك. من يخطىء يجب أن يدفع بعقوبة. فقط هذه ليست بالنهاية، لكن بداية التوبة، لأنه يختبر رقة الغفران. الله لا يرفض العدالة. فهو يشملها ويرفعها إلى حدث أعلى حيث نختبر المحبة التي هي أساس العدالة الحقيقية".
فالبعد الله -الرحمة يدعو الكنيسة نفسها إلى أن تتخّذ سلوك وموقف، بحيث تصبح الرحمة "نهائية وشكل الكنيسة" من "الداخل والخارج". وكي تأخذ شكل مؤسساتي وجعل إعلانها للإنجيل له مصدقية، وكي تستطيع أن تشهد بشكل حقيقيّ من خلال تنظيمها رغبتها بالتفضيل "محبة العدالة" عن "عدالة المحبة". لأنَّ المحبّة الإنجيلية والميل للرحمة يتخذان معا قيمة تفسيرية عليها يؤسس ويُفسّر الشرع الكنسيّ.
والمحبة الرعويّة يجب أن تكون حاضرة دائما في كل نشاط كنسي. لكن المحبّة لا يمكنّها أن تؤثر على العنصر النزاهة في عمل القاضي، لأن المحبّة لا تعني منح الرغبة من يحثّ على بطلان الزواج، حتى لو كان الطرفان يطلبانها. تفترض المحبة الحقيقة، كما يقول يسوع: "لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكمًا عادلا" (يوحنا 7: 24). أهمية النزاهة في إعطاء حكم أعلن رسميا عنها القديس بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس: "أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين، لمراقبة هذه الأمور دون أن تفعل شيئا للمحسوبية" (5: 21).
ومع ظهور البابا فرانسيس على كرسي بطرس نجد "وتيرة التغيير" واضحة، أصبحت مسألة الإصلاح تسير بشكل واضح في الأساليب، وأيضًا في الهيكليات. المرجع الأساسيّ لمشروع البابا فرنسيس الإصلاحي في الكنيسة والذي يعتبر مهمّ وأساسيّ هو الإرشاد الرسوليّ "فرح الإنجيل"، حيث تناول موضوع "الإصلاح"، مستخدمًا أحيانًا عبارات مماثلة: "تحويل" أو "تجديد". فقد أكّد البابا فرانسيس في "فرح الإنجيل" على ضرورة "إصلاح الهيكليات والتي يتطلب إرتداد رعويّ، وأنه يمكن فهمه إلا في هذا المعنى: بحيث تصبح كلّها إرساليَّة، وأنّ يكون الرعوي العادي في جميع درجاته أكثر اتساعًا وانفتاحًا، وأن يضع الفاعلين الرعويين في سلوك ثابت من "الخروج" وأن تفضل الإجابة الإيجابية لجميع الذين يقدّم لهم يسوع صداقته".
النقطة الانطلاق بالنسبة للبابا هو الوعي بضرورة التغيير الجذري في الكنيسة على ضوء الرسالة التبشيرية المتجددة. والبابا لا يتردد من التأكيد على الحاجة إلى "مسار التمييز، تنقية والإصلاح"، وهذا يتطلب أولا وقبل كل شيء "تحوّل في البابوية" (رقم 32) من خلال اللامركزية صنع القرار، وتقييم الكنائس البطريركية القديمة والمجالس الأسقفية في مختلف البلدان: "إنَّ مركزية المفرطة -يلاحظ البابا- بدلا من أن تساعد، تعقّد حياة الكنيسة وديناميّتها الإرساليَّة" (رقم 32). ومن هنا جاءت الدعوة الموجهة إلى الهيئة الكنسيَّة بأكملها من أجل "إعادة التفكير في الأهداف والبنى والنمط وأساليب التبشير بالإنجيل" (رقم 33). في نفس الخط، وحتى في التقليد القديم، يدعو البابا إلى التمييز الدقيق بين ما ينبغي الاحتفاظ بها، ويبدو عفى عليها الزمن، وبالتالي ينبغي التخلي عنها: "توجد أنظمة وأحكام كنسيّة كانت لربّما فعّالة في أزمنة أخرى، لكنَّها لم تعد تتمتّع بالقوّة التربويَّة عينها كمسارات حياة" (رقم 43). وهنا تظهر ضرورة للانتقال من كنيسة ذاتية المرجع إلى "الكنيسة المنطلقة "كنيسة مشرّعة الأبواب (رقم 46). كنيسة غير منغلقة في أمانها الخاصّ ولكنها تنطلق نحو الآخرين للذهاب إلى الضواحي البشريَّة" (رقم 46)، مع علمها بالمخاطر الكامنة في الاختيار "كنيسة منطلقة": "أفضل كنيسة مصابة ومجرّحة وملوّثة لأنَّها سلكت الطرقات، على كنيسة سقيمة بسبب الانغلاق ورفاهة التمسّك بأمانها الخاصّ" (رقم 49). ضمن هذا السياق، يستخدم البابا في هذه الوثيقة مصطلح "إصلاح" في الكنيسة المحلية والكنيسة الجامعة. وهذا المفهوم "الإصلاح" بالنسبة للبابا فرنسيس هي "عملية تنقية" للكنيسة والسماح "بالوصول إلى الجميع" والتغلب على الإغراءات القانونية التي من شأنها أن تهدد من "تحويل ديننا إلى العبودية".
في الواقع، تحدّث البابا فرانسيس في رسالته Misericordiae vultus (11 نيسان 2015) بصفة خاصة عن العلاقة بين العدالة والرحمة (رقم 20-21) وأكد على سيادة رحمة وجوهر العدالة، اللتين تتجلين في التوبة الصادقة عن الخطايا والرغبة في عدم ارتكاب الخطيئة فيما بعد، وبالتالي، لإزالة، إلى أقصى حد ممكن، أي مناسبات لإهانة الله، على الرغم من تداعيات لاحقة، ولكن قوية بغفران الله المستمر "حتى سبعين مرة سبع مرات" (متى 18: 22): "الرحمة لا تتعارض مع العدالة ولكنها تعبّر عن سلوك الله تجاه الخاطئ، مقدّماً له إمكانية أخرى لتوبة والارتداد والايمان... إذا توقف الله عن العدالة فإنه سوف يتوقف عن أن يكون الله، وسيكون على مثال البشر الذين يدّعون إلى احترام الشرع. فالعدالة لوحدها غير كافية، وتعلم التجربة أن اللجوء إليها فقط يهدد بتدميرها. لهذا السبب الله يذهب أبعد من العدالة مع الرحمة والمغفرة. وهذا لا يعني تقليل من قيمة العدالة أو جعلها سطحية، بل على العكس من ذلك. من يرتكب الأخطاء سيتعين عليه أن يتحمّل عقوبتها. ولكن فقط هذه ليست النهاية، لكن بداية التغيير، لأنَّه يختبر رقة المغفرة. الله لا يرفض العدالة. فهو يضمها ويتفوق بحدث أعلى حيث نختبر المحبّة التي هي أساس العدالة الحقيقية" (رقم 21).